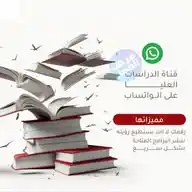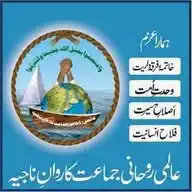مجلة البيان
1.0K subscribers
About مجلة البيان
قناة تختص بنشر مقالات مجلة البيان.. - الموقع الإلكتروني: https://albayan.co.uk - تطبيق العدد الرقمي: http://onelink.to/albayan
Similar Channels
Swipe to see more
Posts

#الورقة_الأخيرة فطرية العبادة بقلم/ محمد السليمان جاءت الشريعة الغراء متَّفقة مع الفطرة السليمة؛ قال تعالى: ﴿فِطْرَة اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَد علَى الفِطْرة»[1]، وجاءت التكاليف متوافقة مع هذه الفطرة ومُوجّهة لها ومُكمّلة ومُغذّية. والتكليف بقدر الطاقة سلوك عامّ في الإسلام، تآزرت عليه آيات القرآن الكريم -بصِيَغ مُتعدّدة-، وأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ، فما يَقدر عليه فرد قد يَعجز عنه آخر، فيُطالَب من الأداء بقَدْر طاقته. والحديث في هذا ينتظم في عددٍ من المناحي والمسارات، نتناول ههنا منها جانبَ فطرية العبادات وتوافقَها مع طبيعة النفس البشرية، بما يُعرَف في المفاهيم الدارجة بـ(البساطة). ورغم أن الأصوليين يُعبِّرون عن عبادات الفعل والترك بـ«التكاليف»؛ إلا أنها في واقعها لا تتجاوز حدود الطاقة والإمكان بلا عسر؛ ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة:١٨٥]، فضلاً عن ارتقاء فئة من المؤمنين إلى درجة الاستمتاع والتلذذ بالعبادة -التي ربما استثقلها غيرهم-؛ لما يجدون من فَيْضها عليهم طمأنينةَ نفسٍ، وراحةَ بالٍ، ورضوانًا من الله وبركات، رائدهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ القائل: «يا بلالُ، أقِمِ الصَّلاةَ، أرِحْنا بها»[2]، والقائل: «وجُعِلَت قُرّة عيني في الصلاة»[3]. فالعبادات تتماشى مع الفطرة والـ(بساطة) وتتقبّلها، ولا تتلاءم مع الميكنة والتقنين والتعقيد -وإن كانت تؤدي الغاية منها بكفاءة مع كافة الظروف-، لكن دون قصد للتكلُّف أو اتخاذه هدفًا يُربط به تنفيذ العبادة؛ فهذا عمران بن حصين -رضي الله عنه- يقول: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: «صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب»[4]. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَزِعًا خائفًا، يقول: يا رسول الله، هلكت! -فقد وقع على امرأته في نهار رمضان، ووجبت عليه الكفارة المغلظة-، فتدرَّج معه النبي صلى الله عليه وسلم نزولاً في سُلّم الاستطاعة؛ مِن عتق رقبة، إلى صيام شهرين متتابعين، إلى إطعام ستين مسكينًا، إلى أن دفَع إليه النبي صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ (مكتل) فيه تَمر ليتصدق به، فيقول الرجل: أعلى أفقر منّي يا رسول الله؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: «أطْعِمْه أهلك»[5]. وأعظم مؤتمرات الدنيا انعقد في الصحراء تحت شجرة؛ ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: ١٨]، ولعل من أسباب ذِكْر الشجرة -رغم عدم أثرها في موضوع البيعة نفسه- بيان فطرية العبادات، وسهولة وسائلها، وعدم التكلف في الاستعدادات لها. وأعظم خُطَب التاريخ كانت تُلْقَى بجوار جذع نخلة، في أشرف مسجد -بعد المسجد الحرام-[6]. ومُتّكأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستندُه في مسجده كان جذعَ نخلة[7]، وصلواته كانت في مسجد صغير المساحة، وفرشه الحصباء[8]، وأعمدته جذوع النخل، وسقفه من جريدها، إذا نزل مطر وَكَفَ على مَن فيه؛ قال الإمام البخاري -رحمه الله-: «باب: بُنْيَان المسجد، وقال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جَرِيد النخل. وأمَر عُمر ببناء المسجد، وقال: أَكِنَّ النَّاسَ من المطر، وإياك أن تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ، فَتَفْتِنَ الناس. وقال أنس: يَتَبَاهَوْنَ بها، ثم لا يعمرونها إلا قليلاً. وقال ابن عباس: لَتُزَخْرِفُنَّهَا كما زخرفت اليهود والنصارى»[9]. ونلحظ من كلام أنس -رضي الله عنه- التلازم العكسي بين انصراف الهمة إلى العناية بالمظهر والتكلّف فيه، وما ينصرف بقَدره من العناية بالمخبر. فالخلاصة: • لا تتكلّف مفقودًا، ولا تَذُمّ موجودًا. • إن توفرت لك الوسائل المساعِدة على الأداء والراحة فبها ونعمت، وإلا فلا تتكلّفها. • خذ من المتاح المباح بقدر الحاجة من غير تكلُّف، وسَايِر ما أُبيح من معطيات عصرك، من غير مبالغة في الطلب ولا في التواضع. • تذكر أن الميزان في هذا كله قول الله تعالى: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ 14 وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ﴾ [القيامة: 14- 15]. وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ----------------------------------- [1] أخرجه البخاري (1319)، ومسلم (2658). [2] أخرجه الإمام أحمد (22578)، وأبو داود (4985)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7892). [3] أخرجه الإمام أحمد (14037)، والنسائي (3940)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3124). [4] أخرجه البخاري (1066). [5] أخرجه البخاري (1834)، ومسلم (1111). [6] انظر صحيح البخاري (3392)، وصحيح مسلم (2658). [7] انظر صحيح مسلم (573)، و(1214)، وأصله في صحيح البخاري (1172). [8] أخرجه مسلم (945)، وأصله في صحيح البخاري (1260). [9] صحيح البخاري (1/171)، وانظر الحديث (638). 🔴 من مقالات #مجلة_البيان عدد (460) لشهر ذو الحجة 1446هـ https://albayan.co.uk/MGZadadarticles.aspx?ID=20208

#أعلام الإمام أحمد بن سليمان قاضيًا عسكريًّا وعالمًا جامعًا بقلم/ أميرة الشناوي السيد في فيض العلم الإسلامي تجد أئمة أعلامًا تفوَّقوا على علماء عصرهم، وأظهروا من فنون العبقرية ما جعلهم معالم وضَّاءة في جبين التاريخ. من أولئك الأفذاذ: الإمام الجليل أحمد بن سليمان، الذي سنُلِمّ ببعض جوانب عبقريته. المتأمل في العالم الإسلامي خلال القرن العاشر الهجري يجد توقيرًا واحترامًا بالغًا للعلوم الإسلامية وتبجيلًا عظيمًا لعلماء الإسلام. ولا غرو في ذلك فقد كان فيهم من النابغين والفحول كثرة كاثرة، وتواصلت مدارسة العلوم، والدأب على الحفظ والمطالعة في المساجد، وغدت معاهد العلم تشعّ بالنور وتُخرّج من عباقرة العلوم نماذج فذة استطارت سُمعتهم في الآفاق، وتحدَّث عنهم الركبان. من علية أولئكم الأعلام: شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا، تركي الأصل، مستعرب، كان جده من أمراء الدولة العثمانية، نشأ أحمد في بيئة عز ومجد، واتجه في صِغَره إلى العلم، فحظي منه بنصيب، لكنه لمّا شبّ ألحقه أهله بالجيش، فانقطع بذلك عن طلب العلم، ولم يُهِج ذلك فيه لوعةً ولا حسرةً، شأن الشبان المنعمين المترفين في كل زمان، فالجاه والنعيم قد أذهلا كثيرًا من الناشئة عن فضيلة العلم. وكان يُرتقب منه أن يغدو قائدًا عسكريًّا حازمًا، وأميرًا مطاعًا، لكن حفَّت به عناية إلهية خاصة رفعته بالعلم والإخلاص مقامًا عليًّا. وقد قصَّ علينا الإمام قصته؛ إذ ارتحل مع السلطان بايزيد خان في سفر، وكان معه وزيره إبراهيم باشا بن خليل باشا، وأمير ليس في الأمراء أعظم منه في ذلك الزمن، اسمه: أحمد بك بن أورنوس. قال أحمد بن سليمان: «فكنت واقفًا على قدمي قدّام الوزير، وعنده هذا الأمير المذكور جالسًا؛ إذ جاء رجل من العلماء رثّ الهيئة دنيء اللباس، فجلس فوق الأمير المذكور -في مجلس أعلى من مجلس الأمير-، ولم يمنعه أحد من ذلك، فتحيَّرت في هذا الأمر، وقلت لبعض رفقائي: من هذا الذي تصدَّر على مثل هذا الأمير؟ قال: هو عالِم مُدرّس، يقال له المولى لطفي. قلت: كم وظيفته؟ قال: ثلاثون درهمًا! قلت: وكيف يتصدَّر على هذا الأمير ووظيفته هذا المقدار؟ فقال رفيقي: العلماء مُعظَّمون لعِلْمهم، فإنه لو تأخَّر لم يرضَ بذلك الأمير ولا الوزير. قال أحمد: فتفكرتُ في نفسي فنويتُ أن أشتغل بالعلم الشريف.[1] لقد تعلق هذا الشاب بالزعامة العسكرية؛ فالشباب عمومًا يَعتدُّون بالقوة، ويطمحون إلى الهيمنة، ويدخل على كثير منهم عُجْب وغرور. فلما طرأت عليه هذه الحادثة لفتت انتباهه إلى أمر أعظم مما تعلّق به وهو طلب العلم، وأثَّرت في مفهوماته، فتغيَّر مجرى حياته جذريًّا. وقد عبّر عن ذلك بقوله: «رجعنا من السفر، وصلت إلى خدمة المولى المذكور «لطفي»، وقد أُعطي عند ذلك دار الحديث بأدرنة»[2]. استقر أمره على أن يعود طالب عِلم، موقنًا أنه شرف عظيم، مَن حظي به فقد حظي -حقًّا- بخير عظيم في الدنيا والآخرة. وتحقق أمله الكبير، فتلقَّى العلم من كبار علماء عصره، منهم: المولى لطفي الرومي، والمولى القسطلاني، المولى خطيب زاده، والمولى معروف زاده، «وصرف سائر أوقاته في تحصيل العلم ومذاكرته وإفادته واستفادته، حتى فاق الأقران، وصار إنسان عين الأعيان»[3]. ثم أقبل هذا الشابّ على الله بصدق وإخلاص ودأب راغبًا فيما عنده، فإن العلم الإسلامي يأبى على العقلاء إلا أن يجعلوه خالصًا لله تعالى. وتُذكّرك تلك الحادثة أيضًا بتوقير حكام المسلمين وقادة جيوشهم لعلماء الإسلام في جميع العصور، وبإدراكهم أهمية آثار العلماء العاملين في توجيه الأمة الإسلامية وصيانة العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق بين المسلمين، عسكريين ومدنيين. وقد قام العلماء بذلك على مر العصور ابتغاء ما عند الله، فحازوا كرامة الدنيا والآخرة. منزلته العلمية اكتمل تكوينه العلمي وصار مدرسًا، وظلّ يترقى في التدريس متنقلًا في مدارس أدرنة من مدرسة إلى أهم منها، حتى درّس في أعظمها؛ مدرسة السلطان بايزيد، ثم عُيِّن قاضيًا بأدرنة، ثم أُعطي قضاء العسكر الأناضولي. ويُفيدك هذا معرفة المسلمين بأهمية القضاء العسكري في انضباط أفراد الجيش وحسن معاملتهم. ثم عُيِّن هذا الإمام الجليل مفتيًا في مدينة إسطنبول عاصمة الخلافة الإسلامية في العهد العثماني، ولم يزل في منصب الإفتاء إلى أن لحق باللطيف الخبير -سبحانه وتعالى-. ودخل أحمد بن سليمان إلى القاهرة بصحبة السلطان سليم خان حين أخذها من الجراكسة، وكان يومئذ قاضيًا بالعسكر المنصور بولاية الأناضول، «وأجاز له بعض علماء الحديث بها، وأفاد واستفاد، وحصَّل بها علو الإسناد، وشهد له علماؤها بالفضائل الجمَّة، والإتقان في سائر العلوم المهمة»[4]. ويبدو جليًّا من سيرة هذا العالِم أنه كان مديد العكوف على المطالعة والتأليف بعزيمة ماضية وهمَّة عالية، وفتح الله عليه حتى «أبدع في إنشائه وأجاد، وكلّ مؤلفاته مقبولة مرغوب فيها، متنافَس في تحصيلها، متفاخَر بتملُّك الأكثر منها، وهي لذلك مستحقة، وبه جديرة»[5]. قال صاحب الشقائق النعمانية، في بيان دأبه على التحصيل العلمي: «كان -رحمة الله تعالى عليه- من العلماء الذين صرفوا جميع أوقاتهم إلى العلم، وكان يشتغل ليلًا ونهارًا، ويكتب جميع ما لاح بباله الشريف، وقد فتر الليل والنهار ولم يفتر قلمه، وصنّف رسائل كثيرة في المباحث المهمة الغامضة، وكان عدد رسائله قريبًا من مائة رسالة، وله من التصانيف تفسير لطيف حَسن قريب من التمام، وقد اخترمته المنية ولم يكمله، وله حواشٍ على الكشاف»[6]. لقد تميز إنتاجه العلمي بالغزارة والجودة مع تنوُّع العلوم التي غاص في بحارها، واستخرج من دررها المعجب المدهش، فلم يقف عند التفسير بل اشتغل بالفقه وشرح كتاب «الهداية» عمدة مؤلفات الفقه الحنفي، وله فيه متن وشرحه، ودوَّن في عِلْم الكلام وعلم الحديث وأصوله، وعلم البلاغة، والفرائض، وأصول الفقه والفلسفة. وكتب في كل ذلك على سبيل التحقيق والتنقيح، مؤلفاته في كل ذلك تفيض بالجديد من النقد والترجيح، ولا يزال معظمها مخطوطًا غير مطبوع. والعجب في ثقافة الرجل أنه كان مثلث اللغات، يتقن العربية، ويتقن التركية والفارسية أيضًا، وله فيهما تآليف تُثبت أنه أبدع فيهما للغاية. ويرى العلماء والنقاد في هذا خير دليل على تبحُّره واطلاعه على هاتين اللغتين إضافةً إلى اللغة العربية[7]. وأثنى عليه مترجموه ثناءً عطرًا، فقال فيه عبد الحي بن العماد الحنبلي: «شمس الدين أحمد بن سليمان الحنفي الشهير بابن كمال باشا، العالم العلامة الأوحد المحقّق الفهامة صاحب التفسير...»... المقال https://albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=33422 🔴 من مقالات #مجلة_البيان عدد(460) لشهر ذو الحجة 1446هـ

#قراءة أسطورة القبر النبوي في الخرائط الأوروبية بقلم/ د. محمود أحمد هدية تحوَّلت البادية العربية وصحراؤها وسُكّانها لفكرة أسطورية بفضل التشكيل المخيالي عند الغرب الأوروبي؛ لما أدَّته التصورات الذهنية في بناء وصناعة «الآخر» ليناسب التمثيلات المتوهَّمة والمتخيَّلة في المنظومة الفكرية والأيديولوجية الغربية، فجاءت الصُّوَر مرتجلةً، نمطيةً، مكررةً، بعيدةً عن الموضوعية لا تعكس الوجه الحقيقي للآخر الذي تم اختزاله في هيئة مرعبة ومخيفة تنحصر وظائفه وأدواره في ما يرغبه ويرضاه الغرب الأوروبي، فأضحوا يُشكِّلون شعورًا بالرعب في الخيال الأوروبي[1]. كما تميل الصور والوحدات الذهنية والأفكار المسبقة لدى الغرب، فيما يتعلق بالإسلام والمسلمين والعرب؛ إلى كونها ذات طبيعة دينية إقصائية بحتة، فمقاربة الإسلام تتم في غالب الأحيان بطريقة تغلب عليها القبليات المشوّهة التي تحمل في ثناياها نُكران الآخر، وتَخلق له صورًا مهولة تُسهّل عليها عملية إبعاده وإقصائه بأقل الجهود. وأسهمت الأساطير القديمة في تشكيل صورة ممزوجة بالخرافات التي التصقت بالإسلام وبرسول الله صلى الله عليه وسلم في خرائط العصور الوسطى؛ لكونها مزيجًا من حقيقة صغيرة مصحوبة بخيال خِصْب ذي طابعٍ متحيّزٍ وغير مُنْصفٍ، وبطبيعة الحال لجأ رسامو الخرائط لتسجيلها على خرائطهم لتكون أساسًا ومرجعًا يُعتمَد عليه؛ لأنَّهم استقوا معلوماتهم من بعض السِّيَر والروايات المتناقلة والمتوارثة في المتون والسرديات الرحلية والسّفريّة العتيدة التي غلب عليها الجانب الخرافي والطابع الغرائبي والعجائبي؛ لافتقاد مُروّجيها الفرصة الحقيقية لمعايشة الحضارة العربية الإسلامية بشكل مباشر. انعكاس الفهم الخاطئ لصورة النبي صلى الله عليه وسلم على الخرائط القديمة: قدَّمت خرائط العصور الوسطى أسطورة لطالما لاقت رواجًا وصدًى في المجتمعات الأوروبية المسيحية، صدى يُغذّي ويلبّي الكراهية التي زرعها البعض من الباباوات ورجال الدين الذين رفضوا قبول الآخر ورسّخوا ذلك في نفوس الشعب الأوروبي، فأنتجت لها أشعارًا وملاحم وقصصًا استطاعت أنْ تُبقِي على تلك الأساطير حتى وقت قريب، فكلّ الخرافات والسّخافات القديمة المنتشرة في الغرب ما وُضِعَت إِلَّا لتشويه صورة الإسلام في عيون أهل الغرب المسيحي، ويبدو أنَّ هذه الصورة أضحت قوية ومترسّخة الجذور «فكانت تتغلّب بسهولة على أيِّ اتصال موضوعي بالمسلمين الحقيقيين»[2]. ومن بين أساطير خرائط العصور الوسطى: أسطورة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، والذي وُصِفَ بالقبر -أو التابوت- المُعلّق على حد تعبيرهم، الطافي في الهواء بفضل الجاذبية أو المغنطة التي تُحيط بقبره -صلى الله عليه وسلم؛ من وجهة نظرهم-. ويعود أصل تمثيل هذه الأسطورة لكتابات أودوريكو دا بوردينوني (حوالي 1265- 1331م)؛ التي أشار إليها في كتابه ltinerarium، بأنَّ قبر النبي محمد يتم تعظيمه وتقديسه هناك، بنفس الطريقة التي يُقدّس بها المسيحيون القبور المقدسة لديهم عند رحلات الحج؛ «مكة هي المكان الذي دُفِنَ فيه محمد، يذهب المسلمون هناك للحج كما يذهب المسيحيون إلى القبر المقدس»[3]. وقد ارتبطت تلك الأسطورة دائمًا بالمدن الدينية الشرقية المهمة سياسيًّا ودينيًّا، مثل مكة المكرمة وبيت المقدس. علاوةً على ذلك، يجب ألَّا ننسى أنَّ الجزيرة العربية كانت للغرب مهدًا للإعجاب بالشرق، لذلك سيكون هناك مجال لبعض الغرائب والعجائب والأساطير، كتلك الأسطورة التي اتسقت بالعقل الأوروبي من خلال تابوت القديس توما الأكويني، والذي اعتقد البعض أنَّه معلّق في الهواء، لذا ربط رسامو الخرائط بينه وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم [4]. ومن بين خرائط العصور الوسطى المتناولة: تلك الأسطورة المتعلقة بخرائط أنجيلينو دولسيرت والمؤرخة بين أعوام 1325- 1339م، من خلال تمثيل مكة المكرمة كأنها بقعة سوداء بين برجين عاليين ممثلين على الخريطتين. ويقدّم النص التوضيحي المجاور للشكل على الخريطة أنَّ «في هذه المدينة يوجد قبر محمد مُعلّقًا في الهواء بحكم الجاذبية»[5]. ويفسّر البعض اللون الأسود الموجود بأنه تمثيل الحجر المغناطيسي الذي يجعل التابوت معلقًا، وهو ما أشارت له الدراسة المتعمقة التي كتبها Sandra Sáenz-Lápez Pérez؛ والتي توضّح أنَّ بعض الخرائط أشارت لـ«تابوت محمد» -على حد تعبيرهم-، يُمثّل الوعاء الذي تُحفَظ فيه رفاته؛ لأنَّه يتّخذ شكل النعش، ومُشابه للهيكل المرتبط بالقبر المقدّس في العقيدة المسيحية، والتوابيت والأواني الجنائزية إبَّان العصور الوسطى والمستخدَمة لحفظ آثار ورفات القديسين، الأمر الذي دعا رسّامي الخرائط الغربيين لتمثيل أشياء مألوفة لديهم وتتطابق مع الغرض المراد تمثيله؛ لأنَّ رؤيتهم لقبره صلى الله عليه وسلم في هذه الخرائط تعود لفكرة أنَّه صلى الله عليه وسلم يُعْبَد مِن قِبَل المسلمين، لذا يجب تقديسه والإشارة لتابوته وقبره[6]؛ على حدّ زعمهم. فكان لا بدَّ من ربط هذه الصورة بالتوابيت ذات التقاليد العريقة والمألوفة لهم في عالم العصور الوسطى والمرتبطة بجِرَار حِفْظ رُفَات القديسين[7]، وهو ما أشار له جويلم سولير في خريطته المؤرخة في 1380م؛ حيث جاء تمثيل قبره صلى الله عليه وسلم مرتكزًا على أرجل صغيرة في قاعدته، ولكنها لا تدعمه فيظهر الشكل معلقًا في الهواء، يصاحبه نصّ يشير لتلك الأسطورة: «مكة: في هذه المدينة قبر محمد النبي...[8] يأتي المسلمون إلى هنا من جميع الأنحاء لرؤية محمد»[9]. كما ربَط بعض الباحثين ممن اهتموا بدراسة أسطورة التوابيت المعلقة؛ بين أسطورة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأحداث الإسلامية، ومنها رحلة الإسراء والمعراج، والصخرة المعلقة ببيت المقدس التي صعد من عليها النبي صلى الله عليه وسلم ليمتطي البراق ليعرج به إلى السماء. كما ربط البعض بينها وبين الحجر الأسود الموجود بالكعبة المشرفة؛ حيث اعتقدوا بأنَّه حجر مغناطيسي، وهو ما أشار له رودريجو خيمينيز دي رادا (حوالي 1170- 1247م) رئيس أساقفة طليطلة[10]، وكان ممثلاً للكنيسة الإسبانية في مجلس ليون الكنسي عام 1245م، والذي تبنَّى فكرة الحرب ضد المسلمين في الأندلس واسترجاع الأراضي من يد المسلمين[11]. ومثَّلت رحلة الإسراء والمعراج حدثًا ذا أهمية في العقيدة الإسلامية، فضلًا عن محتواها الإعجازي، فاحتلت مركزًا جوهريًّا في التأويل والسرد؛ كونها من أَجَلّ المعجزات وأعظم الآيات التي تفضَّل بها المولى -سبحانه- على نبيِّه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم ، دون بقية الأنبياء؛ فلم يَسبق لبشرٍ أن قام برحلة مشابهة[12]، فالقائم بالرحلة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبر رحلة ليلية «أُفقية» عبر الزمان والمكان، أُسرِي به فيها من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى على ظهر البراق، مع صعود –معراج- «رأسي» إلى السماء... المقال https://albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=33433 🔴 من مقالات #مجلة_البيان عدد(460) لشهر ذو الحجة 1446هـ

#في_دائرة_الضو «الدّين» هو المشكاة التي تضيء الطريق للكاتب والأديب «سعاد الناصر» بقلم/ محمد عبد الشافي القوصي إذا كانت «وردة اليازجي» رائدة الأدب النسائي في لبنان، و«مـاري عجمي» في سوريا، و«باحثـة البادية» في مصر، و«عاتكة الخزرجي» في العراق، و«آمال لواتي» في الجزائر، و«سُهيلة حمّـاد» في السعودية، و«مباركة بنت البـراء» في موريتانيا؛ فإنَّ «سـعاد الناصر» عميدة أديبات المغرب، ورائدة الأدب النسائي بلا منازع! نعم، إنها إحدى الرائدات في ميادين الفكر والثقافة والإبداع، وأنموذج لأديبة عصاميَّـة، وأستاذة أكاديميَّـة، ورائدة الكتابة النسائية بالمغرب العربي... تتقاطع قصة حياتها ورحلتها الفكرية مع أخواتها الرائدات الأوائل في أرجاء الوطن العربي؛ مِن حيث المصاعب والعقبات التي اعترضت مَسيرتهنَّ الثقافية، ولكن نجحنَ في اجتياز تلكَ المِحَن والاختبارات بامتياز. عُرِفت «سـعاد الناصر» بلقب (أُمّ سـلمى)! وعن هذا اللَّقب الذي اشتُهِرت به، وأمهرت به كثيرًا من إبداعاتها ومؤلفاتها، تقول عنه: «ليس ذلكَ من أجل إخفاء الاسم الحقيقي كما يفعل بعضُ الكُتّاب، وإنما هذه الحكاية تعود إلى فترة ميلاد ابنتي «سلمى»، حين نشرتُ قصيدتي الأولى بصحيفة «ميثاق الشباب» في تشجيع الناشئة، فاخترتُ هذا اللَّقب تيمنًا بابنتي سلمى». مسيرة (أُم سـلمى) تروي قصَّـة نضال وتألُّق، قِصَّة كفاح ونجاح، ورحلة مثابرة ومصابرة وجهاد مع الورقة والقلم أثمرت عن عددٍ كبير من الروائع الإبداعية التي أينعت في مجالات: الشّعر والقصة والرواية والتحقيق والدراسات النقدية؛ التي ذاعت شُهرتها، وآتت أُكُلَها، وأغدقت على الساحة الثقافية، فمَن لَم يُصبِه مِنها وابلٌ فطل! لمْ يتوقّف قطارها الثقافي عند هذا الحد، بلْ واصلت مسيرتها بعزمٍ وإيمان، فأشرفت على الرسائل العلمية، وأنشأت المجلات الثقافية، وترأسّت الأندية الأدبية، وشاركت في المؤتمرات الثقافية الدولية، وانعقدت حول روائعها الندوات النقاشيَّة، وأُلّفت عنها الكُتب والدراسات النقدية، وحازت على الجوائز والنياشين. قضايا المـرأة والرجـل لا تكتب (أُم سـلمى) عبثًا أو اعتباطًا، أيْ: لا تكتب من أجل الأدب، أو من أجل الفن، بلْ الأدب والفن عندها من أجل قِيَـم حياتيَّة عليا، ومبادئ سامية... وكثيرًا ما تُردِّد أنَّ «على الأديب أن يُخْلِصَ لرسالته، وألَّا يجعلها أداة انحراف وفساد». يقول النقَّاد: إنها كاتبة صاحبة رسالة، ولها مشروع إصلاحي يَحمِل همًّا عربيًّا وإسلاميًّا، عبَّرت عنه بشتَّى الوسائل، ومختلف ألوان الكتابة الأدبية كالمقالة والقصيدة والرواية والقصة القصيرة، حتى المحاضرات والمناظرات والندوات والحوارات الصحفية واللقاءات الإذاعية! هذا «المشروع الإصلاحي» يُركّز على «قضية المرأة» بصفة خاصة، وقد تجلَّى ذلك من خلال أعمالها: «بوح الأنوثة»، و«توسّمات جارحة»، و«السرد النسائي بين قلق السؤال وغواية الحكي»، و«التخييل الروائي للعنف والمقاومة»، إلى جانب القصص والدواوين الشّعرية. ومع تأصيلها لأدب المرأة وتعزيز وجوده؛ كثيرًا ما تؤكد أنَّ الإبداع لا جنسَ له، بل له هوية الجدة والأصالة. ولا يمكن البحث فيه عن خصوصية نابعة من جنس كاتبه، إنما تنبع خصوصيته ممَّا يتفرد به فنيًّا وجماليًّا، وما يتميز به موضوعيًّا. وفي أتون دفاعها عن (قضايا المرأة وحقوقها) التي أولتها اهتمامًا كبيرًا، لا تَتعصَّب للمرأة، ولا تنتصِر لها على حساب الرجل، ولا تُعمِّق الثنائية المفتعَلَة بخلْق قضية للمرأة وقضية للرجل وقضية للطفل، وإنما تعالج قضية الإنسان -بصفة عامة-، وتتفاعل مع أزماته وصراعاته والبحث عن حلول لمعاناته، وفي ذلك تقول: «مُخطئٌ مَن يَعتبر أنَّ العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة صراع وتضاد، وأنَّ مصلحة أحدهما لا تتحقَّق إلَّا على حساب مصلحة الآخَر، لكنّ الحقيقة أنَّ العلاقة بينهما هي علاقة مساواة وتكامل من أجل التعاون على أداء تكاليف الحياة، وأنَّ أيّ تصوُّرٍ آخَر عن هذه العلاقة يُفْضِي بها إلى درب مسدود، ويُغرِق ما يُعرَف بقضية المرأة في مستنقعات آسنة... فمشكلات المرأة لا تعدو كونها جزءًا من مشكلات كبرى مرتبطة بالإنسان، فلا مجال للحديث عن قضية المرأة دون إدراجها في قضية أشمل وأعم، هي قضية التحرُّر العام؛ لأنَّ كل أشكال القمع والعنف والإرهاب والاستعباد والاستغلال المُمارَس ضد المرأة، ليست سوى صورة منعكسة مِمَّا يُمارَس ضد الإنسان، ابتداءً مِن الممارسات الفردية والاجتماعية، وصولًا إلى الممارسات الدولية من ترهيبٍ وحصارٍ واحتلال، لذا فإنَّ أيّ معالجة للحرية أو المساواة أو الحقوق أو غيرها من الموضوعات، يجب أن تُعالَج ضمن علاج أزمة حرية الإنسان وحقوقه، وقضية المرأة ترتبط بقضية الإنسان؛ فالمساواة الحقيقية تكمُن في إعطاءِ كلٍّ ما يستحقه من احترام وتكريم ومناصب. «أم سلمـى» شـاعـرة وروائية «أُم سـلمى» أديبـة موهوبة بحق، تألَّقت في كتابة الشّعر والقصة والرواية، ولا ترى أفضلية لون أدبي على لونٍ آخَـر، بلْ ترى أنَّ للكاتب الحقَّ في التعبير عمَّا يريد، وبالصيغة التي يريدها، فلكلّ جنس أدبي خصائص تُميِّزه عن الآخَر، والأجناس الأدبية جميعًا تتساوى في السيادة، كلّ وَفْق مجاله، ووَفْق مدى البراعة والجودة في إتقانه؛ فامتلاك الكاتب -شاعرًا كان أو روائيًّا- لناصية الكتابة وشروطها يَمنحه القدرة على الإبداع في الجنس الذي يرى أنه الأكثر تعبيرًا عمَّا يريد، فإذا كان الشِّعر أو القصة القصيرة يأتيان كومضات برق خاطف، فعلى الشّاعر أو القاصّ القبض على بريقهما، واقتناص لحظاتهما الإبداعية، ويمكن قراءتهما أكثر من مرة. وتنصح الأدباء بالقبض بقوة على قراءة النصوص الجيدة قبل خوض غمار الكتابة في أيّ جنس أدبي، ولكن تبقى القصيدة تُمثِّل قلقًا للشعراء قديمًا وحديثًا. أمَّا الرواية -من وجهة نظرِها-؛ فإنها تحتاج إلى وقتٍ أطول وتأمُّلٍ أوسع، لذا يمكن للرواية أن تتضمن عددًا من الأجناس وتحتويها... فالنصوص الإبداعية السردية التي لا تتضمّن الروح الشعرية هي مجرد محاكاة جامدة للواقع. قد لا نكون مُبالغين إذا قلنا: إنَّ «أُم سـلمى» مولودة لتكون قاصَّة وروائية، فقد أصدرت عدة مجموعات قصصية غير مسبوقة، منها: «إيقاعات في قلب الزمن»، و«ظلال وارفة»، ورواية «كأنّها ظلّة»، وغيرها. ولا نكون مبالغين -أيضًا- إذا قلنا: إنها مولودة شاعـرة، فقد كتبت القصائد البديعـة، وأصدرت ديوان «لعبة اللانهاية»، وديوان «فصول من موعد الجمر»، وديوان «سأُسمِّيك سنبلة»، وديوان «هل أتاك حديث أندلس؟». ولِـمَ لا؟ وهي الشغوفة بقراءة روائع الأدب منذ طفولتها، فتأثرت بكثير من الشعراء كالمتنبي وأبي العلاء. ومِن المُحْدَثين: نازك الملائكة، والسيّاب، وصلاح عبد الصبور، وحسن الأمراني، ومحمد عليّ الرباوي، وأمينة المريني، ومليكة العاصمي. وفي مجال السرد قرأت للكثير من أدباء الشرق والغرب، مثل: ديستوفسكي، وتوماس مان، وريبيكا غولد شتاين، وجين أوستن، ونجيب محفوظ، وقد تأثرتْ كثيرًا بالروائية «رضوى عاشور»، خاصةً في «ثلاثية غرناطة»، وقالت عنها: «لقد أبدعتْ -رضوى- وأجادتْ، وأثارتْ قضايا لامست فيها قضايا الأنثى والوطن السليب!»... المقال https://albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=33420 🔴 من مقالات #مجلة_البيان عدد(460) لشهر ذو الحجة 1446هـ

#بصائر_قرآنية إنَّ مُعاذًا كان أُمَّة! بقلم/ د. عبدالكريم بن عبدالله الوائلي أسند الطبري إلى فروة بن نوفل الأشجعي -رحمه الله تعالى- قال: «قال ابن مسعود: إن مُعاذًا كان أُمَّةً قانتًا لله حنيفًا، فقلت في نفسي: غلِط أبو عبدالرحمن، إنما قال الله تعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ} [النحل: 120]؛ فقال: تدري ما الأُمَّةُ، وما القانت؟ قلت: الله أعلم! قال: الأُمَّةُ الذي يُعَلِّم الخير، والقانتُ: المطيعُ للهِ ولرسولِه، وكذلك كان معاذُ بن جبل؛ كان يُعلِّمُ الخيرَ، وكان مطيعًا للهِ ولرسوله»[1]. ويعتضد بأثر عمر -رضي الله عنه- قال: «لو استَخْلفت معاذ بن جبل... سمعت نبيك وهو يقول: إن العلماء إذا حضروا ربهم كان بين أيديهم رَتْوَة بحجر»[2]. والبُعد الإشراقي في هذا الأثر؛ تلك المعاني العميقة التي أراد ابن مسعود -رضي الله عنه- إيصالها للناس وعظًا واستصلاحًا، فمنها ما يظهر لذي النظر أنه -رضي الله عنه- أراد أن يُبيِّن للناس أن سيرة الأنبياء سيرة بشرية، وأنه بمقدور البشر التأسي بهم، وهذا من الأهمية بمكان؛ إذ يختلط على الناس مفهوم عصمة الأنبياء وإمكان التأسي بهم. ومن المعاني التدبرية في هذا الأثر: ما يُومِئ إليه ابن مسعود من تربية تلامذته بنحو تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: «وكذلك كان معاذ»، كما يجد الباحث في هذا الأثر عِظَم تجرُّد الصحابة؛ فابن مسعود -رضي الله عنه- كان برتبة معاذ، وأقدم منه إسلامًا، ولكنّها النفوس الكبيرة والأخلاق الرفيعة حين تتجسَّد في معاملات هؤلاء الكبار؛ رضي الله عنهم وأرضاهم. ويظهر في الأثر: تعليم التدبُّر من خلال البناء المنهجي للهداية، في توظيف ابن مسعود -رضي الله عنه- لاستشكال ذهنية تلميذه واستثمارها في الهداية؛ مما يدل على أن السؤال والمباحَثة مع المتلقّين من المفاتيح المهمّة للمتدبّرين؛ فهي من أعظم طرق مُفاتَشة القرآن، كما أن تولّد السؤال يسبقه نظر وتأمل. ويبيِّن الأثر وسيلة أخرى من وسائل التدبر؛ وهي: مجالس المُدَارَسة، فينبغي إحياؤها في المساجد والبيوت والدروس، كما كان يفعل السلف الصالح -رحمهم الله تعالى-. فرضي الله عن ابن مسعود وعن معاذ وعن صحابة نبينا -صلى الله عليه وسلم- أجمعين. ---------- [1] تفسير الطبري (14/394). [2] الرتوة هنا الخطوة أي: يتقدمهم بخطوة، ويقال بدرجة، وقيل برمية سهم، وقيل بمثل، وقيل بمدى البصر. يُنظَر: لسان العرب، ابن منظور (14/ 308)، مادة (رَتَا)، والأثر أخرجه أحمد في فضائل الصحابة، فضائل أبي عبيدة بن الجراح (2 /742). 🔴 من مقالات #مجلة_البيان عدد(460) لشهر ذو الحجة 1446هـ https://albayan.co.uk/MGZadadarticles.aspx?ID=20208

#نص_شعري قُمْ ساجدًا بقلم/ أحمد مثقال القشعم قُمْ ساجدًا لله وادْعُ طَوِيلا وَتمَلَّ أَخْذَ الظَّالِمِينَ وَبِيلا كَبِّرْ وَسبِّحْ بُكْرَةً وَأَصيلا وَاجْأَرْ لِرَبِّك ساجِدًا وَذَلِيلا سَقَطَ المُطَبِّل والمُزَمِّرُ فِي المَدَى مَلَأَ الدُّنا كَذِبًا وَهَاجَ طُبُولا في أَهْلِ سُنَّتِنا مَشَى مُسْتَأْسِدًا وجَنَى المَصَائِبَ بَاغِيًا ضِلِّيلا أَعَلى طَرِيقِ القُدْسِ صِحْتَ مُجَلْجِلاً وَدَعَوْتَ رَبَّكَ أَنْ تَمُوتَ قَتِيلا؟! يَا شَرَّ كَذّابٍ خَسِئْتَ فَهَذِهِ طَعَنَاتُ حِقْدِكَ ما تَزَالُ دَلِيلا يَا بُوقَ فَارسَ بُؤْ بخُسْرانٍ فقد قَاءَ الزَّمَانُ مِنَ الصُّرَاخِ طَوِيلا قد خُنْتَ فَاحْصُدْ أَيُّها الوَثَنُ الَّذِي شَقَّ الصُّفُوفَ وَأَتْقَنَ التَّهْوِيلا ذُقْ مِنْ كُؤُوسِ الذُّلِّ مُتْرَعَةَ القَذَى كَمْ قَد جَرَعْنَا مِنْ أَذَاكَ سُجُولا كَم قَدْ سَلَلْتَ سُيُوفَ غَدْرٍ مَا ارْتَوَتْ حَتَّى أَسَلْتَ مِنَ الدِّماءِ سُيُولا سُقْتَ البَهَائِمَ صَائِلاً بِبِلَادِنَا وَلَدَى العِدا تَعْنُو أَذلَّ خَذُولا فَمِنَ العِرَاقِ حُثَالَةٌ مَوْتُورةٌ جَاءَتْ لِتَأْخُذَ ثَأْرَهَا المَطْلُولا لُبْنانَ قَاسَى الوَيلَ وَاليَمَنُ الَّذِي أَوْهَيْتَ لُحْمَتَه فَصَارَ فُلُولا وَالشَّامُ حَيثُ جَعَلْتَ ثَأْرَكَ مُتْعَةً وَزَرَعْتَ مِنْ نَسْلِ البُغَاةِ رَعِيلا قَد أَنْتَنَتْ مِنْهُمْ مَشَارِفُ جِلَّقٍ وَغَدَتْ مَرَابِعُهَا قَذًى وَطُلُولا يَا بْنَ الأَراذِلِ كَم قَصَفْتَ مَآذِنًا وَنَشَرْتَ فَوْقَ بُنَى الكِرَامِ سُدُولا وَأَتَيتَ بِالفُرْسِ الرَّعَاعِ لِيَلْطُمُوا فِي سَاحِ مَسْجِدِها الخُدُودَ عَوِيلا وَأَتَيْتَ قَبْرَ صَحَابَةٍ كَتَبُوا الهُدَى دَاسُوا المَجُوسَ وأَزْهَقُوا التَّضْلِيلا هُمْ تَاجُ رَأْسِكَ بَلْ تَأَذَّى رَافِضًا مِنْ أَنْ يَمسَّ مِنَ المَجُوسِ رَذِيلا مِن أَينَ لاِبْنِ الفُرْسِ نَسْلُ مُحَمَّدٍ؟! نَحْنُ البُنُوَّةُ أَفْرُعًا وَأُصُولا هذا عَلِيٌّ وَالحُسَيْنُ وَحَمْزَةٌ سَادَاتُنا أَكْرِمْ بِذَاكَ عُدُولا كَمْ تَدَّعُونَ مَحَبَّةً ووِراثَةً! هَيهَاتَ أَنْ تَجِدُوا لِذَاكَ دَلِيلا! مَنْ سَبَّ أَصْحَابَ النِّبيِّ مُحَمَّدٍ هَلَّا يَكُونُ بِحُبِّه مَشْمُولا؟! هَتَكُوا حِجَابَ الأُمَّهَاتِ فَأَصْبَحَتْ مُتَعُ الزِّنَا في عِرْضِهِم تَأْصِيلا رَفَعُوا الرِّجَالَ وَأَلَّهُوهُمْ ضِلَّةً فَغَدا الإِمَامُ بِعِصِمَةٍ مَكْفُولا قد غَيَّروا الدِّينَ القَوِيمَ وَأَوْغَلُوا هَدْمًا وَمَا بَلَغُوا الهَوَى المَأْمُولا ضَرَبَ الإِلهُ المُجْرِمِينَ بِبَعْضِهِم يَا رَبِّ خُذْهُمْ للجَحِيمِ قَبِيلا يَا رَبِّ بَدِّدْ شَمْلَهُم ثُمَّ احْصِهم عَدَدًا وَزِدْهُم في الوَغَى تَقْتِيلا أَللهُ يا أَلله زِدْهُم ذِلّةً أَثْخِنْ بِآياتِ الخَنا تَنْكِيلا وَاخْفِضْ لهم هَامَ النِّفاقِ وَلا تَذَرْ مِنْهُم عَلَى أَرْضِ الكِرامِ عَمِيلا نَشَروا الفَوَاحِشَ وَالفَظَائِعَ وَادَّعُوا حِزْبًا يُقَاوِمُ فِي الفِراغِ خُيُولا هذي فِلِسْطِين الذَّبِيحَةُ شَاهِدٌ قد أَسْلَمُوها للعِدا تَحْلِيلا لِتَظَلَّ إِيرانُ المَجُوس سَلِيمَةً تَطَأُ البِلادَ وَتَسْتَزِيدُ غُلُولا هذا النَّهَارُ بِهِ القُلُوبُ تَضَرَّعَت لله تَجْأَرُ بُكْرَةً وَأَصِيلا هذي شَآمُ بَنِي أُمَيَّةَ لم تَزَلْ تَسْقِي الأَعَادي عَلْقَمًا وَذُحُولا كم مِن فَرَاعِنَةٍ أَتَوْهَا فَانْثَنُوا يَتَجَرَّعُونَ خَسارَةً وَخُمُولا رَحَلَ الطَّغَاةُ وَلم تَزَلْ تَعْنُو لِمَنْ رَفَعَ السَّماءَ وَأَحْكَمَ التَّنْزِيلا اللهُ أَكْبَرُ قَد تَسَامَى فَيْضُها فَهَمَى الأَذَانُ سَكِينَة وَقَبُولا #مجلة_البيان عدد(460) لشهر ذو الحجة 1446هـ https://albayan.co.uk/MGZadadarticles.aspx?ID=20208

#قضايا_تربوية العقاد حاجًّا بقلم/ صلاح عبد الستار محمد الشهاوي حصل الكاتب والمفكر والشاعر عباس محمود إبراهيم مصطفى العقاد (يونيو 1889- مارس 1964م) على الشهادة الابتدائية عام 1903م من مدرسة أسوان الأميرية، وعمره أربع عشرة سنة، ولعدم توافر المدارس الحديثة، وعَجْز موارد أُسرته المحدودة عن إرساله إلى القاهرة لإكمال تعليمه -كما كان يفعل أعيان أسوان في ذلك الوقت-؛ اقتصرت دراسته على المرحلة الابتدائية فقط. وَلِع العقاد بالقراءة في مختلف المجالات، بعد أن أغراه الشيخ أحمد الجداوي -تلميذ الشيخ جمال الدين الأفغاني- بالقراءة الحرة، فلم يُفارقها إلى آخر عمره. التحق العقاد في سنّ مبكرة بعمل كتابي بمحافظة قنا، ثم نُقِلَ إلى محافظة الشرقية ليعمل بوظائف حكومية كثيرة بها، منها: مصلحة التلغراف، ومصلحة السكة الحديد، وديوان الأوقاف، لكنه ضاق بها وتركها. وعندما تُوفِّي والده، انتقل العقاد إلى القاهرة، واستقر بها، وبدأ يعمل بالصحافة. ثم اختاره العلامة محمد فريد وجدي ليعمل معه محررًا بجريدة الدستور عام 1907م، وفي عام 1908م أحرز نجاحًا باهرًا بمقابلة أجراها للصحيفة مع وزير المعارف سعد زغلول. وبعد توقف الجريدة عام 1912م، عاد إلى الوظيفة بديوان وزارة الأوقاف بالقاهرة. ثم تركها وعمل مع رفيق عمره الأديب إبراهيم عبد القادر المازني مُعلِّمًا بمدرسة الإعدادية الثانوية بالقاهرة. ثم بمدرسة النيل الخاصة. ثم ترك التعليم، وعاد إلى الكتابة بالصحافة. بدأت صلة العقاد الحقيقية بالكتابة عام 1917م؛ عندما عمل مع محمد عبد القادر حمزة بجريدة الأهالي التي كان يُصدرها، وفي عام 1919م عمل العقاد بجريدة الأهرام، ثم البلاغ عام 1922م، ارتبط العقاد بجريدة البلاغ، وملحقها الأدبي الأسبوعي لسنوات طويلة حتى عام 1935م، وبعد هذا العام وجَّه العقاد تدريجيًّا نشاطه إلى التأليف الأدبي والفكري. العقاد والإسلام بعدما نفَض العقاد يديه من العمل الصحفي والسياسي؛ اتجه بعقله وقلبه صوب الإسلام، باحثًا عن الحقائق الإيمانية، للرد على أباطيل الخصوم، وتشكيك المتعطلين والمتردّدين، ولجاجة الماديين والمتكلمين. وإسلاميات العقاد تدل على أنه فهم الإسلام بوصفه القضية الكبرى في هذا الوجود، ولا بد من الإخلاص لها، والجهاد في سبيلها حتى آخر لحظة في العمر، وتدلّ كثرة إسلاميات العقاد وتنوُّعها على الإيمان العميق الذي كان يتغلغل في قلبه، والذي أفصَح عنه في قوله: «أؤمن بالله وراثةً، وشعورًا وبعد تفكير طويل؛ أما الوراثة فإنني قد نشأت بين أبوين شديدين في الدِّين، لا يتركان فريضة من الفرائض اليومية، وفتحت عيني على الدنيا وأنا أرى أبي يستيقظ قبل الفجر ليؤدي الصلاة ويبتهل إلى الله بالدعاء، ولا يزال على مصلاه إلى ما بعد طلوع الشمس، فلا يتناول طعام الإفطار حتى يفرغ من أداء الفرض والنافلة وتلاوة الأوراد. ورأيت أمي في عنفوان شبابها تؤدي الصلوات الخمس، وتصوم وتُطعم المساكين، فللوراثة شأن عندي من سليقة الاعتقاد. أما الإيمان بالشعور فذاك أن مزاج التدين ومزاج الأدب والفن يلتقيان في الحسّ والتصور والشعور بالغيب، وربما كان وعي الكون أو الوعي الكوني الذي يتعلق به كل شعور بعظمة العالم وعظمة خالق العالم، والوعي الحيوي مصدر النفس، والوعي الكوني مصدر الدين. أما الإيمان بالله بعد تفكير طويل، فخلاصته أن تفسير الخليقة بمشيئة الخالِق العالِم المُريد أوضح مِن كل تفسير يقول به الماديون، وما من مذهب اطلعتُ عليه من مذاهب الماديين إلا وهو يُوقِع العقل في تناقض لا ينتهي إلى توفيق أو يُلجئه إلى زعمٍ لا يقوم عليه دليل. وبعدُ، فإيماني كله في العقيدة والأخلاق والمعاملة والأدب يُوزَن بميزان واحد، وهو ميزان المثل الأعلى أو طلب الكمال؛ لأنه إيمان يُغنينا عن طلب الجزاء إلا من الله، ويُعزينا عن فقدان الحمد والثناء من الناس». العقاد حاجًّا في العام 1946م، وقبل زيارة الملك عبدالعزيز إلى مصر، تشكَّلت بعثة من كبار رجال الدولة المصرية لتكون في شرف مصاحبته خلال رحلته بالباخرة من جدة إلى السويس، وكان الكاتب الكبير عباس العقاد أحد أعضاء هذه البعثة الذين توجهوا من جدة إلى مكة لأداء فريضة الحج، ولقاء الملك عبدالعزيز؛ حيث دار بين العقاد والملك حديث طويل حول العروبة والإسلام وأمن الحجيج، ومستقبل الأمة. وقد طرب العقاد كثيرًا لآراء الملك وأفكاره وحماسته لخدمة قضايا الأمة، وسجل العقاد مشاعره وتأملاته في أثناء زيارته لمكة المكرمة والحرم الشريف في مقالين نشرهما في مجلة الرسالة (العدد 655 بتاريخ 21 يناير 1946م، والعدد 659 بتاريخ 18 فبراير 1946م). في هذين المقالين يُحدّثنا العقاد عن وعثاء السفر ومشقة الرحلة، كما حدَّثنا عن رفقاء الرحلة الذين استقلوا سيارة خاصة بهم، وأنه استأذنهم عندما أشار قائد السيارة إلى غار حراء، قائلًا لهم: «لا بد أن أصعد بنفسي الجبل، وأجلس في المكان ذاته الذي اجتمع فيه أمين الوحي مع الصادق الأمين حينما قال له: اقرأ». وتساءل العقاد بعد أن خاض تجربة الصعود إلى غار حراء: «كيف كان النبي الكريم يُخاطر بنفسه في الصعود إلى هذا المكان المظلم لكي تشعّ منه أنوار الوحي، وتنبعث منه هدايات السماء، وتنطلق منه أعظم حضارة شهدتها البشرية جمعاء». ثم قال العقاد واصفًا غار حراء: «هو قمة مرتفعة في جبل كأنما بُنيت بناءً على شكل التبة المستطيلة إلى الأعلى، ولكنها عسيرة المرتقى، لا يبلغها المصعد فيها إلا من شعاب وراء شعاب، وأخبرني مَن صعده أنهم كانوا يعانون شديد العناء من وُعورة مرتقاه، وأن القليل من الناس يصمد في صعوده إلى نهايته العليا؛ حيث كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يتنسك ويبتهل إلى الله تعالى». ثم يقول العقاد: «وحسبك نظرة واحدة إلى الجبل ومرتقاه لتحيط بعض الإحاطة بتلك النوازع المرهوبة التي كانت تنهض بالرسول -صلى الله عليه وسلم- في شبابه إلى ذروة تلك القمة مرات بعد مرات وأيامًا بعد أيام. وبعد النزول من الجبل عبرنا خاشعين مطرقين، وسكتنا لأن مهبط الوحي هنالك قد ألهمنا السكوت»... المقال https://albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=33415 🔴 من مقالات #مجلة_البيان عدد(460) لشهر ذو الحجة 1446هـ

#الباب_المفتوح (أرشيف) المرأة في مرآة المفكر مالك بن نبي بقلم/ أ.د. حفيظ اسليماني إن المطلع على ما كتب حول المرأة سيجد كماً كبيراً من الكتب والمقالات حول هذا الموضوع، إلا إن الكتب التي أعطت الموضوع حقه منهجياً قليلة، وسنتوقف في هذا المقال مع المفكر الجزائري مالك بن نبي ومقاربته لموضوع «المرأة»، خصوصاً أنه صاحب نظرة إصلاحية مبنية على المنهج، ويكفي القارئ أن يعود إلى كتبه ليقف على سعة فكره وتصوره للتغيير الحقيقي. «قضية المرأة» وفق رؤية المفكر مالك بن نبي ليست قضية يتم البحث فيها بعيداً عن قضية الرجل، بل القضيتان معاً في حقيقتيهما قضية واحدة، وهي قضية «الفرد والمجتمع»، وهنا يرى ابن نبي أنه عند التطرق للموضوع من الضروري استبعاد أولئك الذين نصبوا أنفسهم ذادة عن الحقوق المرأة من كتاب الشرق أو الغرب، كما يرى أيضاً أنه ليس بمجدٍ عقد مقارنة بين الرجل والمرأة ثم نخرج بنتائج كمية تشير إلى قيمة المرأة في المجتمع وأنها أكبر أو أصغر من قيمة الرجل، أو تساويها، فليست هذه الأحكام سوى افتئات على حقيقة الأمر ومحض افتراء، بل أكد أن الأقاويل عن حقوق المرأة وتحريرها أو المطالبة بإبعادها من المجتمع مجرد تعبير عن نزعات جنسية لاشعورية. يرى ابن نبي أنه ينبغي أولاً أن تصفى هذه النزاعات، ثم تُحل القضية حلاً يكون الاعتبار فيه لمصلحة المجتمع، فالمرأة والرجل يكونان الفرد في المجتمع: فهي شق الفرد، كما أن الرجل شقه الآخر. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: «النساء شقائق الرجال»، والله عز وجل خلقهما من نفس واحدة، مصداقاً لقوله الكريم: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً} [النساء: ١]، يقول ابن نبي: «المرأة والرجل قطبا الإنسانية، ولا معنى لأحدهما بغير الآخر، فلئن كان الرجل قد أتى في مجال الفن بالمعجزات، فإن المرأة قد كونت نوابغ الرجال. ونحن نرى لزاماً علينا أن يكون تناولنا للموضوع بعيداً عن تلك الأناشيد الشعرية، التي تدعو إلى تحرير المرأة، فالمشكلة لا تتحدد في الجنس اللطيف فحسب، أو في بنات المدن، أو بنات الأسر الراقية، بل هي فوق ذلك تتعلق بتقدم المجتمع وتحديد مستقبله وحضارته»[1]. يؤكد ابن نبي أيضاً أنه إذا ما تساءلنا: هل يجب نزع الحجاب؟ هل يسوغ للمرأة التدخين؟ أو التصويت في الانتخابات؟ أو هل يجب عليها أن تتعلم؟ فينبغي ألا يكون الجواب على هذه الأسئلة بدافع مصلحة المرأة وحدها، بل بدافع حاجة المجتمع وتقدمه الحضاري، إذ ليست الغاية في إشراكها في هذا المجتمع إلا الإفادة منها في رفع مستوى المرأة ذاتها، إذن ليس من المفيد النظر إلى مشكلة المرأة بغير هذا المنظار. يقول ابن نبي: «ولقد نعلم أنه يضيق صدر بعض ذوي الأذواق الرقيقة بما نقول. فيحتجون علينا بأن مثل هذا الموقف يذيب المرأة في المجتمع، ولكننا نقول لهم: إن إعطاء حقوق المرأة على حساب المجتمع معناه تدهور المجتمع، وبالتالي تدهورها، أليست عضواً فيه؟ فالقضية ليست قضية فرد، وإنما هي قضية مجتمع»[2]. كما انتقد ابن نبي قضية اللباس وصلتها بحل المشكلة، قائلاً: «لقد بدأت المرأة المسلمة التي كانت إلى زمن قريب تلبس (الملاية) في إفراط تسلك في سيرها الاجتماعي الطريق الذي رسمته أوربا لنسائها، متخيلة أن في ذلك حلاً لمشكلتها الاجتماعية»[3]، وهنا يتأسف ابن نبي من حصر نساء الشرق مشكلتهن في الزي، مؤكداً أن مشكلة المرأة مشكلة إنسانية يتوقف على حلها تقدم المدنية، فلا يكون حلها بمجرد تقليد ظاهري لأفعال المرأة الأوربية، دون نظر إلى الأسس التي بنت عليها المرأة الأوربية سيرها. إن مسألة تحديد مهمة المرأة في المجتمع، ينبغي النظر إليها وهي تسير منسجمة مع المشكلات الاجتماعية الأخرى في سبيل تقدم المدنية. ويتساءل ابن نبي: هل من المفيد للمرأة المسلمة أن نجعلها في مركز تشبه فيه أختها الأوربية؟ وهنا يقول ابن نبي إنه بشيء «من النظر نرى أن انتقالنا بالمرأة من امرأة محجبة إلى امرأة سافرة، تطالع الصحف وتنتخب، وتعمل في المصنع لم يحل المشكلة، فهي لا تزال قائمة، وكل الذي فعلناه أننا نقلنا المرأة من حالة إلى حالة»[4]. يعطي ابن نبي المثال بمشكلة النسل لدى أوربا، فبمشكلة النسل فقدت أوربا تنظيمها الاجتماعي إلى حد ما. هكذا إذن يرى ابن نبي أنه من الواجب أن توضع المرأة هنا وهناك حيث تؤدي دورها خادمة للحضارة، وملهمة لذوق الجمال وروح الأخلاق، ذلك الدور الذي بعثها الله فيه أماً، وزوجة للرجل. وحبذا لو أن نساءنا عقدن مؤتمراً عاماً يحددن فيه مهمة المرأة بالنسبة لصالح المجتمع، حتى لا تكون ضحية جهلها، وجهل الرجل بطبيعة دورها فإن ذلك أجدى علينا من كلمات جوفاء ليس لها في منطق العلم مدلول، يقول: «إني لا أرى مشكلة المرأة بالشيء الذي يحله قلم كاتب في مقال أو في كتاب. ولكني أرى أن هذه المشكلة متعددة الجوانب، ولها في كل ناحية من نواحي المجتمع نصيب؛ فالمرأة كإنسان تشترك في كل نتاج إنساني أو هكذا يجب أن تكون»[5]. وقد انتقد مالك بن نبي عمل المرأة الأوربية، معتبراً أن المجتمع الذي حررها قذف بها إلى أتون المصنع في بيئة مليئة بالأخطار على أخلاقها، وتركها في حرية مشؤومة، ليس لها ولا للمجتمع فيها نفع، يقول ابن نبي: «نعم إننا نرى المرأة في تطور، ولكننا لم نشرع بعد في التخطيط الدقيق لجميع أطوارها، فنحن نراها في مظاهرها الجديدة فتاة في المدرسة، وفي حركة كشفية، وفي تسابق في الحياة العامة، عاملة، ومولدة، وطبيبة، ومدرسة، وعاملة في المصنع والأوتوبيس، ونائبة...»[6]. ونبه ابن نبي إلى أنه مهما يكن عجزنا كبيراً عن تخطيط مراحل تطور الفتاة المسلمة، فإنه يلزمنا عند أي تخطيط ألا نغفل بعض القضايا الجوهرية، كقضية «الحضور» أي حضور المرأة في المجتمع حضوراً بيِّناً. يقول ابن نبي: «القضية إذن من حيث إنها تتطلب التنفيذ هي في النهاية موقوفة على من بيده وسائل التنفيذ. ولا شك أن مؤتمراً يحدث فيه ما يسميه الفقهاء بالإجماع هو الكفيل بهذا، فالقضية تتطلب بالضبط إجماعاً»[7]. وما تجدر الإشارة إليه أن المسايرة ضرورية لينجح المشروع، مشروع تكون فيه المرأة إلى جانب أخيها الرجل يداً في يد لبناء مجتمع حضاري بعيداً عن الشعارات النظرية. وجملة القول، إن المفكر مالك بن نبي قد أفلح في التطرق لموضوع المرأة، مبيناً عيوب غيره في مقاربة الموضوع، مقدماً الحل والمنهجية الصحيحة التي يجب على الجميع اتباعها لتكون المرأة عنصر التغيير الحقيقي رفقة للرجل، بعيداً عن التفرقة غير المعقولة التي لن تزيد الطين إلا بلة، فالمرأة ركيزة أساسية في عملية البناء الحضاري، فتهميشها هو تعطيل لمشاريع النهوض التي تعيد للأمة مجدها... المقال https://www.albayan.co.uk/MGZArticle2.aspx?ID=5905 🔴 من مقالات #مجلة_البيان عدد(363) لشهر ذو الـقـعـدة 1438 هـ

#قضايا_تربوية (أرشيف) دعائم تربوية من خلال الموعظة القرآنية بقلم/ د. أحمد بن بازز الحديث عن التربية حديث مهم تنبع أهميته من أهمية التربية نفسها، وذلك باعتبارها المدخل الصحيح لإيجاد الشخصية المسلمة المتزنة المستقيمة، وتنشئة جيل فاقهٍ لدينه متمسك به، عامل به وداعٍ إليه، ليحقق خيرية الأمة[1]. ويَحسُن بنا في بداية هذا المقال أن نعرِّف بالتربية من جانبيها (اللغوي والاصطلاحي): التربية في اللغة: يقول الراغب الأصفهاني: الرب في الأصل: التربية، وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً، إلى حد التمام، يقال: ربه ورباه ورببه[2]. أما في الاصطلاح الشرعي فهي: تنشئة الفرد وإعداده على نحو متكامل في جميع الجوانب العقدية والعبادية والأخلاقية، والعقلية والصحية، وتنظيم سلوكه وعواطفه في إطار كلِّي يستند إلى شريعة الإسلام[3]. من هنا يتبين أن التربية - بمفهومها الإسلامي - تُعنَى بتصحيح التصورات، ثم تصحيح التعبدات، ثم تصحيح السلوك الاجتماعي[4]. وهذا ما تجسده موعظة لقمان التي نحن بصدد استخراج الدعائم التربوية منها. تتضمن الآيات - موضوع الدراسة - منهجاً تربوياً سامياً لمن امتثلها وعمل بمقتضاها كما يريد الآباء ورجال التربية... وهي تغنيهم عن غث النظريات التربوية المستوردة. جاءت هذه الموعظة تحمل إلينا دعائم تربوية من الأهمية بمكان، يستفيد منها المربي قبل المُربَّى (المتلقي)، ولا يستطيع المهتم بمجال التربية - مهما كان متضلعاً ومتخصصاً في هذا العلم - أن ينكر أهميتها وشموليتها لكل المناحي (الدينية والدنيوية)، في الأخلاق والآداب والمعاملات. قال - تعالى -: {وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْـحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ 12 وَإذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ13 وَوَصَّيْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلَيَّ الْـمَصِيرُ 14 وَإن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إلَيَّ ثُمَّ إلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 15 يَا بُنَيَّ إنَّهَا إن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ 16 يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْـمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْـمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ 17 وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ 18وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إنَّ أَنكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْـحَمِيرِ} [لقمان: 12 - 19]. بين يدي الموعظة: مما ينبغي أن نشير إليه ها هنا أن هذه الموعظة اتسمت بأمور جعلتْها بليغة ومثمرة: أولاً: أنها حكيمة وصادرة من حكيم[5]. ثانياً: استعمل لقمان الحكيم أسلوب النداء من باب المجاز لطلب حضور الذهن لوعي الخطاب. ثالثاً: استعمل التصغير لكلمة الابن (بني) لتنزيل المخاطَب الكبير منزلة الصغير كناية على الشفقة به والتحبب له، وفي مقام الموعظة يدل على تمحض النصح، وفيه حث على امتثال الموعظة. رابعاً: تكرار أسلوب النداء بين هذه الوصايا التي ضمتها الموعظة لتجديد نشاط السامع لوعي فحوى الخطاب. ويستفاد مما ذكر أن استقبال الخطاب وفهم مراميه يختلف من شخص لآخر وَفْق استعداداته وإمكاناته العقلية، ولذلك ينبغي مراعاة ذلك حتى يكون لما يُلقيه المربي (أباً كان أو مدرساً) من أقوال أو توجيهات قبول حسن ينتفع به سامعه[6]. إن القرآن قد زكى هذه الموعظة الحكمة فسطرها - سبحانه – في كتابه وصية ذهبية صالحة لكل زمان ومكان، متى امتثلها الإنسان انتفع بها أيما انتفاع، ونحن من منطلق عقيدتنا الإسلامية أَوْلى بها من غيرنا، وأن نستفيد منها كما سطرها الوحي في ثنايا المصحف الشريف، دون أن تحتاج إلى صياغتها في قوالب تشبه تلك النظريات التربوية الفاشلة المستوردة (بأموال طائلة) من غرب عالمنا وشرقه لأسماء بشرية يعتري النقص والقصور أفكارهم. وقفة مع لقمان الحكيم: من باب الوقوف على قائل هذه الموعظة البليغة لمعرفة أسبابها ونتائجها والعلاقة بين القائل والسامع يَحسُن بنا أن نعرِّف بصاحب النص (الذي حكى القرآن موعظته) على عكس البنيويين الذين يقولون بموت صاحب النص. فلقمان: اسمه لقمان بن عنقاء بن سدون، وكان أسود البشرة، اختلف أهل العلم في شأنه: هل هو نبي أم حكيم صالح فقط، غير أن ما ذهب إليه الجمهور أنه لم يكن نبياً بل كان حكيماً قذف الله في قلبه الحكمة فنطق بها[7]، وقد قال الله - تعالى -: {وَمَن يُؤْتَ الْـحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذَّكَّرُ إلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ} [البقرة: 269]. مع الموعظة: بيَّن أهل العلم أن الأقوال المنسوبة إلى لقمان كثيرة، وقد عدَّ الطاهر بن عاشور[8] في تفسيره حِكَمه المأثورة في سبعين حكمة غير ما ذُكر في سورة لقمان موضوع بحثنا التي جمعت أصول الشريعة، وهي... المقال https://albayan.co.uk/MGZArticle2.aspx?ID=1544 🔴 من مقالات #مجلة_البيان عدد(293) لشهر محرم 1433 هـ

#قضايا_تربوية (أرشيف) إعجاز فواتح سور القرآن وخواتيمها بقلم/ د. إيمان مصطفى علي إن المتأمل في فواتح سور القرآن وخواتيمها يدرك لوناً بديعاً من ألوان الإعجاز، ذلك أنَّها جاءت بألوان من الإعجاز الذي يؤكد المراد من قوله: {لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ} [الإسراء: ٨٨]! فبالنسبة لفواتح السور القرآنية؛ جاءت في غاية البراعة، وغاية الروعة: تارةً باستهلالها بتنزيه الله وتمجيده، وتارةً بالنداء، وتارةً بالاستفهام، وتارةً بالأمر، وتارةً بالحروف المقطعة لتشويق القارئ أوْ المستمع لما سيأتي بعدها من خطاب.. إلخ. ومن يتأمل جميع فواتح السور؛ يلحظ دلالتها على مقصود السورة وأغراضها، وقد يكون واضحاً أحياناً، وأحياناً أخر يحتاج إلى نوع من التدبر والتأمل، والتفكر في استخراج تلك الدلالة. ولنتأمل هنا مناسبة فواتـح السور لما قبلها، ومناسبة فواتح السور لمقاصدها وموضوعاتها، ومناسبة فواتح السور لخواتيمها؛ كي نفقه دلائل الإعجاز القرآني، وعظمة التنزيل الحكيم! مناسبة فواتـح السور لما قبلها: انظر إلى مطالع السور، ومدى ارتباطها الشديد بما قبلها؛ فمن تدبر خاتمة سورة الفاتحة ودعاء المؤمنين ربَّهم أنْ يهديهم الصراط المستقيم، ثمَّ نظر في افتتاح سورة البقرة، حيث قال سبحانه: {ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ} [البقرة: ٢]، أيْ: إنهم لما سألوا الله الهداية، بَيَّن لهم سبيلها. وفي خاتمة سورة آل عمران أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ} [آل عمران: 200]، ثمَّ مالَ إلى الناس كافة في سورة النساء فأمرهم بالتقوى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ} [النساء: ١]، لأنه ليس كل الناس يستطيع الصبر والمصابرة والمرابطة، فكان افتتاح سورة النساء مناسباً لما خُتِمت به سورة آل عمران. وهكذا يمضي الترابط بين سور القرآن كلها، وكأنها سورةٌ واحدة.. وقد تجلَّى من هذا إعجاز نفسي عجيب؛ يجعل القارئ المتدبِّر مستغرِقاً في لطائف التوجيهات الإلهية، والشواهد الربَّانية، فمثلاً: اختتم سبحانه سورة الواقعة بالأمر بالتسبيح: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الواقعة: 74]، ثمَّ افتتح بعدها مباشرة سورة الحديد بالتسبيح، فقال: {سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ} [الحديد: ١]! وفي سورة الفيل أخبر بما حدث لجيش أبرهة الذين أرادوا الاعتداء على البيت العتيق، وكيف أهلكهم بأصغر الطير وأضعفه: {فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ} [الفيل: ٥]، فجاءت بعدها سورة قريش وهي شديدة الاتصال بما قبلها؛ لتعلُّق الجار والمجرور في أولها بالفعل: {لإيلافِ قُرَيْشٍ} [قريش: ١]، وقد طالبهم في هذه السورة بالإيمان بربِّ هذا البيت، وشكر: {الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ} [قريش: ٤]. ثمَّ أعقبتها سورة الماعون التي توعد فيها تارك الصلاة، وذَمَّ الذين لا يطعمون الطعام: {فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ 4 الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ 5 الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ 6 وَيَمْنَعُونَ الْـمَاعُونَ} [الماعون: ٤ - ٧].. وهكذا. من هنا نعلم أنَّ افتتاح كل سورة في غاية المناسبة لما قبلها، ولكنه يخفى تارة ويظهر تارةً أخرى، ولا يدرك ذلك إلا من رزقه الله تعالى قوة التدبُّر والتفكُّر في كتاب الله العزيز. مناسبة فواتح السور لمقاصدها: برغم أن القرآن نزل مُنجَّماً ومتفرِّقاً على ثلاث وعشرين سنة؛ إلا أنه تمَّ مترابطاً محكماً متناسقاً في بناء جُمَلِهِ وآياته لفظاً ومعنى.. لذلك تجد مطلع كل سورةٍ من سور القرآن متناسقاً متناسباً مع مقاصد تلك السورة، تنتقل فيها من آية لآية، ولا تجد تنافراً بين كلماتها أو آياتها. وهذا فن من فنون البلاغة واللغة يدل على حُسن الصياغة وتماسك البناء. والأمثلة على ذلك كثيرة وفيرة، منثورة في جميع سور القرآن المجيد، ولكن الحاذق هو وحده من يدركها ويتلمس قدرته تعالى وإعجازه فيها. قال صاحب الإتقان: «أجاب ابن الزملكاني حين سُئِلَ عن الحكمة من افتتاح سورة الإسراء بالتسبيح، والكهف بالتحميد؟ بأنَّ سورة (سبحان) لمَّا اشتملت على الإسراء الذي كذَّبَ المشركون به النبيّ، وتكذيبه تكذيب للهِ سبحانه، أتى (بسبحان)، لتنزيه الله تعالى عمَّا نُسِبَ إلى نبيِّهِ من الكذب، وسورة الكهف لمَّا أُنزِلت بعد سؤال المشركين عن قصة أصحاب الكهف وتأخُّر الوحي، نزلت مُبيِّنةً أنَّ الله لم يقطع نعمته عن نبيِّهِ ولا عن المؤمنين، بلْ أتمَّ عليهم النعمة بإنزال الكتاب، فناسب افتتاحها بالحمد على هذه النعمة»[1]. • مثــال آخَـر: سورة النور استهلَّها المولى تعالى بقوله: {سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} [النور: ١] وقد كرَّر قوله: {لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ} [النور: 46] عدة مرات؛ للتأكيد على هذه التشريعات، ووجوب الالتزام بها، فقد شرع في هذه السورة كثيراً من الأحكام والأخلاق والآداب؛ فقد حذَّر من الإفك والبهتان، ورميْ المحصنات الغافلات، ونهى عن دخول البيوت دون استئذان، وأمر بِغَضّ البصر، وتجنُّب الفواحش، وأمر بالصلاة والزكاة، وأدب الحديث مع الجناب النبوي الشريف، وقد كرَّر الأمر بطاعة اللهِ ورسولِه. • مثــال آخـر: سورة الفتح استهلها سبحانه بقوله: {إنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا} [الفتح: ١] وهو الفتح الأكبر، ودخول الرسول وأصحابه مكة في عزَّةٍ ومهابةٍ وجلال، وتطهيرهم الكعبة من الأصنام والأوثان، ثمَّ الثناء على المؤمنين الذين بايعوا الرسول في بيعة العقبة. ثمَّ صلاتهم بالبيت: {تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ} [الفتح: 29]. • مثــال آخر: سورة الرحمن استهلَّها الحقُّ تعالى باسمه {الرَّحْمَنُ} [الرحمن: ١] الذي وهب كل هذه الآلاء والنِّعم على عباده، ليؤمنوا به ويشكروه عليها. وطالبهم بعد ذِكْر كل نعمةٍ أنْ يُقرُّوا بها ويعترفوا، وكرَّر عليهم السؤال: {فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} [الرحمن: 13]، ثمَّ تلتها سورة الواقعة مباشرة، بقوله سبحانه: {إذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ} [الواقعة: ١]، لأنها تتحدث عن الأهوال التي سيشهدها الناس يومئذ، والمشاهد التي سيرونها رأيَ العين، وجزاء كل فريقٍ من الناس بحسب ما قدَّمتْ يداه! مناسبة فواتح السور لخواتيمها... المقال https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=6644 🔴 من مقالات #مجلة_البيان عدد(385) لشهر رمـضـان 1440 هـ