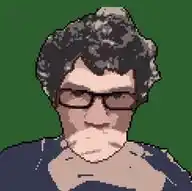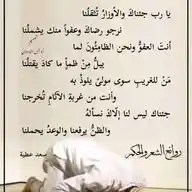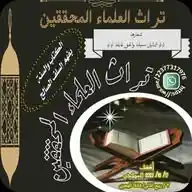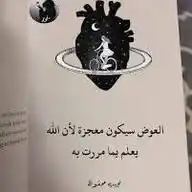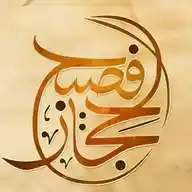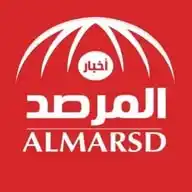الدكتور علي زين العابدين الحسيني
116 subscribers
About الدكتور علي زين العابدين الحسيني
كاتب وأديب، متكئ على التراث، ومتجه إلى المعاصرة، محافظ على القديم الصالح، وآخذ بالجديد الأصلح.
Similar Channels
Swipe to see more
Posts

#ومضة_تعليق هذا القول المنسوب إلى بعض أهل العلم من أنه كان يُقرئ “المنهاج” ابتداءً لطالب العلم بحجة ضيق الوقت لا ريب أنه قول لا يخلو من نظر، وإن كان قائله يُقدر؛ لأن “المنهاج” كتاب متين العبارة، محشو بالخلاف والاختيارات، وفيه كثير من التقعيدات الدقيقة، ولذا لا يحسن أن يُدرّس لطالب لم يُؤسس على ما قبله من المتون. وقد جُرّب هذا، فتبين أن غالب من يشرع في دراسة “المنهاج” مباشرة يجد مشقة كبيرة في تحصيله، ويعجز عن تصور كل مسائله على وجه سليم، لأنه لم يُمهَّد له بسلم تعليمي متدرج، يُخرجه من تصور المسائل الفقهية في صورتها المجردة إلى فقه الخلاف في المذهب، ولا يتصور هذا الخلاف الوارد في “المنهاج” على وجهه إلا إذا مرّ الطالب على متون مختصرة تعينه على تصوّر المسائل على الجادة. ثم إن من مقاصد العلم الحفاظ على “رسم الطلب”، وسلوك السبيل الذي مشى عليه الفقهاء في تدرجهم، وهذا من أصول التربية العلمية، والشيخ سالم الخطيب نفسه سلك طريق التفقه على المنهج المألوف، فلم يبدأ بـ”المنهاج”، وإنما مرّ بما قبله من المتون المتداولة في التدريس كما في ترجمته، فأنى يصح أن يُختصر الطريق لطالب ناشئ، ويُقذف به في عباب الخلاف قبل أن يُتقن السباحة فيه؟! على أنه قد يفتح الله على بعض الطلبة فيختصر له الزمان، ويحسن التحصيل في وقت وجيز، وقد حُكي عن بعض الأئمة أنهم قرأوا الفقه في شهرين أو ثلاثة، لكن هذه نوادر لا يقاس عليها، ولا تُتخذ أصلاً لتقرير مناهج التفقه. ومن علامات الفقيه أن يعرف قدر طالبه ومستواه العقلي، فيهبه ما يناسبه، لا ما يُعجّل بنتيجته على غير بينة، فـ”المنهاج” بالتجربة ومن واقع تراجم العلماء يحتاج إلى آلة، ودربة، ومعرفة بمصطلحات المذهب، وإلا تحوّل إلى حاجز بين الطالب وبين الفهم. ونعاني أيضًا في كتب المذهب من إشكالية واضحة، وهي أن الطالب يدرس كتابًا كـ”عمدة السالك” لابن النقيب قبل “المنهاج”، مع أن “العمدة” محدود في مسائله، لا سيما في أبواب المعاملات وما بعدها، فإذا انتقل الطالب بعده إلى “المنهاج” شعر بفجوة كبيرة، وواجه سيلًا من المسائل التي لم يمرّ بها من قبل، فيتردد الطالب: هل يصرف همه إلى فهم المسائل الجديدة، أم ينشغل بتحقيق مواضع الخلاف المذهبي؟! ومن هنا تظهر الحاجة الملحة إلى وجود كتاب وسيط بين “عمدة السالك” و”المنهاج”، يُمهّد الطريق، ويُغني الطالب عن الانشغال بتصور المسائل عند دراسته “للمنهاج”، ليتفرغ آنذاك لفهم الخلاف على وجه أدق. وقد يسّر الله لي طريقة لمعالجة هذا الإشكال، وسد هذه الثغرة، وهي مما أرجو أن يكون فيه نفع لطالب الفقه الشافعي.

هيبةُ الشعر باقيةٌ في القلوب لا ينبغي أن تُمس، ولا يليق أن يتناول حرمته إلا من استكمل عُدَّته، وتأهَّب بعتاده. ومن طال تأمُّله في دواوين الأوائل أدرك تلك الهيبة المضمَرة بين السطور. وقد كان شيخي السيّد الراوية "شاعر الرسالة" محمد عبد الرحيم التلاوي إذا أنشد بيتًا ألبسه من جلال حضوره ما يُعيد للشعر مهابته الأولى. ولذلك لا أُسلّم بأنّ انفعالًا عابرًا من حزنٍ أو فرح يُبيح للمرء أن يكتب ما يظنه شعرًا، وهو لا يعدو أن يكون كلماتٍ مرصوصة في قوالب موزونة، لا روح فيها ولا امتداد؛ إذ الشعر أوسع من أن يُختزل في لحظة، وأجلّ من أن يُفرَّغ في بيتين لا يحملان غير الصدى. ومن أراد أن يكتب الشعر فليتأمّل جلاله قبل أن يتجرأ على بابه؛ فإن لهذا الفنّ مهابته التي لا تحتمل الابتذال.

النووي: ولد الإمام "يحيى بن شرف بن مري النووي" في شهر الله المحرم سنة 631، ونشأ ببلدة "نوى" قرية من الشام بدمشق، وقرأ بها القرآن، وقدم دمشق سنة 649، وقرأ على الأئمة الأعلام؛ ككمال الدين سلار الإربلي وعبد الرحمن المقدسي وأبي الفتح عمر بن بندار التفليسي وإبراهيم بن عمر الواسطي، وكان يقرأ على مشايخه في اليوم والليلة اثني عشر درساً في عدة علوم، وحجّ مع والده سنة 651، وله حجة أخرى، وابتدأ في التصنيف سنة 660، وله تصانيف عظيمة انتفع بها أهل الإسلام، وتولى "دار الحديث الأشرفية" سنة 665، وقد زار القدس والخليل، ورجع في آخر عمره إلى نوى، ومرض عند أبويه إلى أن توفي في الرابع والعشرين من شهر رجب سنة 676، ودفن بها. الأنصاري: ولد شيخ مشايخ الإسلام "زكريا بن محمد الأنصاريّ" سنة 824 بسنيكة قرية بمحافظة الشرقية، حفظ القرآن الكريم وبعض المختصرات بها، وقدم القاهرة سنة 841 وحفظ بها بعض المتون؛ كالمنهاج وألفية ابن مالك والشاطبية، وعاد إلى بلدته واشتغل بالفلاحة قليلًا، ثم رجع إلى القاهرة وانقطع لتحصيل المعارف في شتى الفنون، وقرأ على الأئمة الأعلام؛ كابن حجر العسقلاني والبلقيني والكمال ابن الهمام وجلال الدين المحلي والزين رضوان والمناوي وزين الدين عبد الرحمن الزركشي الحنبلي ومحمد بن علي القاياتي وابن المجدي، فقرأ على مشايخه جميع الفنون الموجودة في عصره، وبرع في علوم الشريعة وآلاتها، وتولى المناصب التدريسية الكثيرة؛ كتولي مشيخة جامع الظاهر والدرس بالمدرسة الصلاحية المجاورة لمقام الإمام الشافعي، والمناصب الإدارية؛ كتولي نظر القرافة وأوقافها ونظر أوقاف المدرسة الصلاحية، والمناصب القضائية؛ كمنصب قاضي القضاة الشافعي في عهد الأشرف قايتباي، وله تصانيف عظيمة انتفع بها أهل الإسلام، وتوفي سنة 926، ودفن بقرب قبر إمامنا الشافعي. الباجوري: ولد شيخ الأزهر والمسلمين "إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري" سنة 1198 بباجور شرق محافظة المنوفية، ترعرع في حجر والده وقرأ عليه القرآن الكريم بتجويده، وقدم القاهرة سنة 1212، ودخل الجامع الأزهر ومكث فيه يسيراً، وبسبب الحملة الفرنسية خرج إلى الجيزة إلى أن عاد إليه سنة 1216، فانقطع لتحصيل المعارف في شتى الفنون، وقرأ على الأئمة الأعلام؛ كحسن القويسني وداود القلعي والفضالي والشرقاوي والأمير الكبير وابنه الصغير، وله تصانيف عظيمة انتفع بها أهل الإسلام، وتولى مشيخة الأزهر العظيم سنة 1263، وتوفي سنة 1276، وصلي عليه بالأزهر، ودفن في مقبرة المجاورين.

ويا ليتَ أعينَنا تبصر عيوبَنا قبل أن تتشوّف للغيوب!

توالت مصنفات المذهب الشافعي، وتكامل البناء في تسلسل عجيب: • تصدّر "مختصر المزني" فحمل مشعل التأسيس، وشغل الأفهام بتهذيب كلام الإمام، وتقرير معالم المذهب. • ثم نهض "المهذّب" للشيرازي، فارتقى بالتقريب، وتصدر المجالس بما امتاز به من متانة الترتيب وحسن السبك. • وجاء "الوجيز" للغزالي، فأجاد في الاختصار، وزاحم بمباحثه المتينة مجالس الدرس ومواطن المدارسة. • وأعقبه "المحرر" للرافعي، فكان نفسُه أمكن، وحُجته أبلغ، فاستقلّ بمكانةٍ سامقة على من قبله. • ثم جاء "المنهاج" للنووي، فالتقت عنده الأنظار، واجتمع عليه الشراح والحفاظ، وصار عمدة المفتين، ومعقد رجاء الطالبين. • وخُتم "بـالمنهج" لزكريا الأنصاري، فصار مع شرحه وحواشيه معتمد المذهب عند المتأخرين، ومرجع القول في مسائلهم. وبين هذه المتون الستة وبعدها متونٌ جليلة وشروحٌ معتمدة هي جسورٌ للطالبين، ومعابر للترقي في سلّم المذهب، تتكامل فيها طبقات التأليف، وتتآزر فيها جهود الأعلام من المتقدمين والمتأخرين! #المذهب_الشافعي #شافعيات

ومن هيبة ديوان #المتنبي في قلبي أني -في بعض الأحايين- أتوقف عند مسّه، وأستمهل يدي قبل أن تمتد، وأقول في نفسي: أيليق بي أن أفتحه وأنا على حالٍ عارضة من الفتور أو التشتّت؟! ذلك أنّي أعتقد أنه ينبغي للقلب أن يتأهّب، وللذهن أن يتطهّر من ضجيجه قبل أن يطرق باب ذلك البهاء المركوز في قصائده!

لا شك أن تحقيقات الطاهر ابن عاشور الأدبية وتصنيفاته تكشف عن نفسٍ أديبة، وملكةٍ متينة، قلّ أن تجتمع بهذا التوازن في عالم من المتأخرين؛ فهي شاهدة على رسوخ علمه، ورهافة ذوقه، وعلوّ همته في اقتحام مسالك البيان ودقائق التعبير.

مصر قلب الثقافة النابض، وعطاؤها العلمي جليل لا يُنكر، ومنجزها في شتى التخصصات والفنون محلُّ نظرٍ واعتناء، وقد استفادت الدنيا كلها من علماء مصر في الماضي والحاضر، فلا تكاد أمة تُعنَى بالعلم إلا وفي صفحاتها أثر مصري، ولا يُذكر المجد العلمي إلا وتلوح فيه أسماء أزهرية، أو أقلام مصرية حفرت حضورها في الوجدان العلمي العربي والإسلامي. ومن الجفاء أن يُقابل الفضل بالتجاهل، أو يُوارى هذا العطاء الممتد لقرون خلف غبار الحسد والتعصب، والعاقل من أنصف، والوفيّ من اعترف لأهل الفضل بفضلهم.

ولستَ تُدركُ ما في حُسنِ الخُلُقِ من كرامةِ المنزلة وجمالِ الأثر حتى تُبتلىٰ بمن ضاقتْ نفسُه، وغَلُظَ قولُه، وساءتْ عشرتُه!

ليس من اللازم أن يكون من يكتب عن مخطوطات المذهب الشافعي ومواضع وجودها فقيهًا متمكنًا من فروع المسائل، وقد كان جلّ من تلقّينا عنهم من أساتذتنا لا يشغلون أنفسهم بهذا الجانب، ولم يكن ذلك منقصةً لهم، ولا مأخذًا عليهم. وكما لا يُشترط فيمن يكتب في المخطوطات أن يكون فقيهًا، فكذلك لا يُعدّ من يجمع مصنّفات أعلام الشافعية ويوثق ذلك في رسالة جامعية من أهل الدراية بالفقه؛ لأن هذا من قبيل الجمع والتوثيق، لا من قبيل التحقيق والدراية بمتون المذهب. ولا ريب أن له فضله في بابه، لكنه لا يُعدّ من أهله في أبواب الفقه حتى يُؤخذ العلم من مأخذه، ويُؤتى البيوت من أبوابها. وإن خُيِّر المرء بين العناية بمسائل المذهب وفهم الشروح وحواشيها، وبين تتبّع مواضع المخطوطات وطبعات الكتب، فلا شك أن الأولى أرفع شأنًا، وأغزر نفعًا، مع حفظ قدر المشتغلين بالمخطوطات، ووضع كلٍّ في موضعه الذي يليق به. على أن التحقيق علمٌ له استقلاله، ولا يُشترط في المحقّق أن يكون فقيهًا مطّلعًا على دقائق ما يُحققه، وإن كان الجمع بين التحقيق والمعرفة بالمذهب أولى وأكمل، ومن وُفّق إليه فذلك فضلٌ عظيم، غير أن المطالع لما طُبع حديثًا من كتب الشافعية يلحظ أن الجامعين بين الأمرين أقلّ من القليل، والأمثلة في ذلك كثيرة. ومن معايشتنا لأهل العلم من أساتذتنا وجدنا عنايتهم منصرفةً إلى فهم المتون والشروح أكثر من التفاتهم إلى تتبّع الطبعات، أو البحث في خزائن المخطوطات، وليس ذلك عيبًا فيهم، ولا حطًّا من قدرهم؛ فكلٌّ ميسَّر لما خُلق له. #المذهب_الشافعي #شافعيات