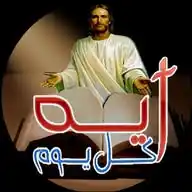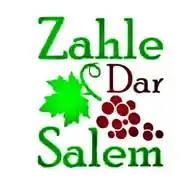الكتاب الشهري
714 subscribers
About الكتاب الشهري
فوائد منتقاة من كتاب محدد شهريا انتقاء: د. أبصار الإسلام بن وقار الإسلام أستقبل الملاحظات والاقتراحات على الرابط التالي: 00966502265369
Similar Channels
Swipe to see more
Posts
*العقلاء يحرصون على تحصيل جميع الكمالات الدينية:* قال ابن الجوزي رحمه الله: *لله أقوامٌ ما رضوا من الفضائل إلا بتحصيل جميعِها، فهم يُبالِغون في كل علمٍ، ويجتهدون في كل عملٍ، ويُثابِرون على كل فضيلةٍ،* فإذا ضَعُفَتْ أبدانُهم عن بعض ذلك، قامت النِّيَّات نائبةً، وهم لها سابقون، - *وأكملُ أحوالِهم إعراضُهم عن أعمالِهم؛* فهم يحتقرونها مع التمام، ويعتذرون من التقصير، - *ومنهم من يزيد على هذا، فيَتَشاغَلُ بالشكر على التوفيق لذلك،* - *ومنهم من لا يرى ما عمل أصلًا؛ لأنه يرى نفسَه وعملَه لسيِّدِه.* وبالعكس من المذكور من أرباب الاجتهاد: حال أهل الكسل والشَّرَه والشهوات، فلئِن الْتَذُّوا بعاجل الراحة، لقد أوجبَتْ ما يزيد على كل تعبٍ من الأسف والحسرة... *ولقد تأملتُ نيل الدُّرِّ من البحر، فرأيتُه بعد معاناة الشدائد.* ومَن تفكَّر فيما ذكرتُه مَثَلًا، بانت له أمثالٌ، *فالموفَّق مَن تلمَّح قِصَر الموسم المعمول فيه، وامتدادَ زمان الجزاء الذي لا آخِرَ له، فانتَهَبَ حتى اللحظةَ، وزاحَمَ كل فضيلةٍ؛ فإنها إذا فاتت فلا وجهَ لاستدراكِها.* أَوَليس في الحديث: *«يُقالُ للرجل: اقرأ وارْقَ، فمَنزِلُك عند آخر آيةٍ تقرؤها»؟ فلو أنَّ الفكرَ عَمِلَ في هذا حقَّ العَمَل، حَفِظَ القرآنَ عاجلًا.* صيد الخاطر (ص ٥٨٨).
*موت المؤمن في الحقيقة انتقال إلى راحة ونعيم:* قال ابن الجوزي رحمه الله: ما زلتُ على عادة الخلق في الحزن على مَن يموت مِن الأهل والأولاد، *ولا أتخايَلُ إلا بِلى الأبدان في القبور، فأحزن لذلك.* فمرَّت بي أحاديث قد كانت تَمُرُّ بي ولا أتفكَّر فيها، منها قول النبي ﷺ: *«إنما نَفْسُ المؤمن طائرٌ يعلق في شجر الجنة، حتى يَرُدَّه اللّٰه عزَّ وجلَّ إلى جسده يوم يبعثُه».* فرأيت أن الرحيل إلى الراحة، وأن هذا البدن ليس بشيءٍ؛ لأنه مَركَبٌ تفكَّك وفسد، وسيُبنى جديدًا يوم البعث، فلا ينبغي أن يتفكَّر في بِلاه، *ولتسكن النفس إلى أن الأرواح انتقلت إلى راحةٍ، فلا يبقى كبير حزنٍ، وأن اللقاء للأحباب عن قربٍ.* وإنما يبقى الأسف لتعلُّق الخلق بالصُّوَر، فلا يرى الإنسانُ إلا جسدًا مُستحسَنًا قد نُقِضَ، فيحزن لنقضِه، والجسد ليس هو الآدمي، وإنما هو مَركَبُه، فالأرواح لا ينالُها البِلى، والأبدان ليست بشيءٍ. *واعتَبِرْ هذا بما إذا قلعْتَ ضرسك ورميتَه في حفرةٍ: فهل عندك خَبَرٌ بما يَلقى في مدة حياتك؟ فحكم الأبدان حكم ذلك الضرس؛ لا تدري النفسُ ما يَلقى.* *ولا ينبغي أن تغتمَّ بتمزيق جسد المحبوب وبِلاه، واذكر تنعُّم الأرواح، وقُرب التجديد، وعاجل اللقاء؛* فإن الفكر في تحقيق هذا يُهوِّن الحزنَ ويُسهِّل الأمرَ. صيد الخاطر (ص ٥٩٢).
*من عجائب تدبير الله: تقسيم المهام والأدوار بين الناس:* قال ابن الجوزي رحمه الله: *سبحان مَن شَغَلَ كل شخصٍ بفنٍّ؛ لتنامَ العيون في الدنيا:* *فأما في العلوم:* فحَبَّبَ إلى هذا القرآنَ، وإلى هذا الحديثَ، وإلى هذا النحوَ...؛ *إذْ لولا ذلك، ما حُفِظَتْ العلومُ.* *وألهم هذا المُتعيِّش أن يكون خبَّازًا،* *وهذا أن يكون هرَّاسًا،* *وهذا أن ينقل الشوكَ من الصحراء،* *وهذا أن ينقي البِذارَ؛* ليلتئمَ أمر الخلق، ولو ألهم أكثرَ الناس أن يكونوا خبَّازين مثلًا، بات الخبز وهلك! أو هرَّاسين، جفَّت الهرايس! *بل يُلهِمُ هذا وذاك بقَدرٍ؛ لينتظمَ أمر الدنيا وأمر الآخرة.* ويَندُر مِن الخلق مَن يُلهِمُه الكمالَ، وطلبَ الأفضلِ، والجمعَ بين العلومِ والأعمالِ ومعاملاتِ القلوب، وتتفاوت أرباب هذه الحال. *فسبحان مَن يخلق ما يشاء ويختار.* صيد الخاطر (ص ٦٢٢).
*كيفية التعامل مع الغضبان:* قال ابن الجوزي رحمه الله: *متى رأيتَ صاحبَك قد غَضِبَ، وأخذ يتكلم بما لا يَصلُح، فلا ينبغي أن تَعقِد على ما يقوله خِنصرًا، ولا أن تُؤاخِذَه به؛ فإنَّ حالَه حالُ السكران، لا يدري ما يجري،* بل اصبر لِفَوْرتِه، ولا تُعوِّل عليها؛ فإن الشيطان قد غَلَبَه، والطبع قد هاج، والعقل قد استتر. *ومتى أخذتَ في نفسك عليه، أو أجبتَه بمقتضى فعلِه، كنتَ كعاقلٍ واجَهَ مجنونًا، أو كمُفيقٍ عاتَبَ مُغمًى عليه، فالذنبُ لك.* بل انظر بعين الرحمة، وتلمَّح تصريف القدر له، وتفرَّج في لعب الطبع به، *واعلم أنه إذا انتَبَهَ، نَدِمَ على ما جرى، وعرف لك فضل الصبر.* وأقلُّ الأقسام: أن تُسلِمَه فيما يفعلُ في غضبِه إلى ما يستريحُ به. *وهذه الحالة ينبغي أن يتلمَّحَها الولد عند غضب الوالد، والزوجة عند غضب الزوج، فتتركُه يشتفي بما يقول، ولا تُعوِّل على ذلك، فسيعود نادمًا مُعتذِرًا.* ومتى قوبِلَ على حالتِه ومقالتِه، صارت العداوة مُتمكِّنةً، وجازى في الإفاقة على ما فُعِلَ في حقِّه وقتَ السُّكْر. *وأكثر الناس على غير هذه الطريق: متى رأوا غضبان، قابَلوه بما يقول ويعمل، وهذا على غير مقتضى الحكمة، بل الحكمة ما ذكرتُه، ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾* [العنكبوت: ٤٣]. صيد الخاطر (ص ٦٠٥).
*إياك والإعجاب بنفسك وعلمك وعملك:* قال ابن الجوزي رحمه الله: *قَلَّ مَن رأيتُ إلا وهو يرى نفسَه! والعَجَب كلُّ العَجَب مِمَّن يرى نفسَه! أتُراه بماذا رآها؟!* - إن كان بالعلم: فقد سَبَقَه العلماء، - وإن كان بالتعبُّد: فقد سَبَقَه العُبَّاد، - أو بالمال: فإن المال لا يوجِبُ بنفسِه فضيلةً دينيةً. فإن قال: قد عرفتُ ما لم يعرف غيري من العلم في زمني، فما عليَّ مِمَّن تقدَّم؟ قيل له: ما نأمُرُك يا حافظ القرآن أن ترى نفسَك في الحفظ كمَن يحفظ النصف، ولا يا فقيهُ أن ترى نفسَك في العلم كالعامِّيِّ، *إنما نَحذَرُ عليك أن ترى نفسَك خيرًا من ذلك الشخص المؤمن وإن قَلَّ علمُه؛ فإن الخيرية بالمعاني لا بصورة العلم والعبادة.* *ومَن تلمَّح خِصالَ نفسِه وذنوبَها، عَلِم أنه على يقينٍ من الذنوب والتقصير، وهو من حال غيرِه على شكٍّ،* فالذي يُحذَرُ منه: الإعجاب بالنفس ورؤية التقدُّم في أحوال الآخرة. *والمؤمن لا يزال يحتقر نفسَه،* وقد قيل لعمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه: إن مِتَّ ندفنُك في حجرة رسول الله ﷺ؟ فقال: *"لَأن ألقى اللهَ بكل ذنبٍ غيرَ الشرك أحبُّ إليَّ مِن أن أرى نفسي أهلًا لذلك".* وقد رُوِّينا: أن رجلًا من الرهبان رأى في المنام قائلًا يقول له: فلانٌ الإسكافيُّ خيرٌ منك! فنزل من صومعتِه، فجاء إليه، فسأله عن عملِه، فلم يذكر كبير عملٍ، فقيل له في المنام: عُدْ إليه، وقل له: مِمَّ صُفرة وجهِك؟ فعاد، فسأله؟ فقال: *ما رأيتُ مسلمًا إلا وظننتُه خيرًا مني، فقيل له: فَبِذاك ارتَفَعَ!* صيد الخاطر (ص ٦٠٤).
*الفضائل والكمالات لا تُنال إلا بالتعب والمشقة:* قال ابن الجوزي رحمه الله: تأملتُ عَجَبًا، وهو أن *كل شيءٍ نفيسٍ خطيرٍ يطول طريقُه، ويَكثُر التعب في تحصيله.* فإن *العلم لما كان أشرف الأشياء، لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار، وهجر اللذات والراحة،* حتى قال بعض الفقهاء: *"بقيتُ سنين أشتهي الهريسة، لا أقدر؛ لأن وقت بيعها وقت سماع الدرس!".* *ونحو هذا: تحصيل المال؛ فإنه يحتاج إلى المُخاطَرات والأسفار والتعب الكثير.* وكذلك *نيل الشرف بالكرم والجود؛ فإنه يَفتقِر إلى جهاد النفس في بذل المحبوب، وربما آلَ إلى الفقر.* وكذلك *الشجاعة؛ فإنها لا تَحصُل إلا بالمُخاطَرة بالنفس.* قال الشاعر: *لولا الـمشقَّةُ سـادَ الـناسُ كلُّـهُمُ* *الـجود يُـفـقِـرُ والإقـدام قَـتَّـالُ* *ومِن هذا الفن: تحصيل الثواب في الآخرة؛ فإنه يزيد* - على قوة الاجتهاد والتعبد، - أو على قدر وقْع المبذول من المال في النفس، - أو على قدر الصبر على فقد المحبوب، ومنع النفس من الجزع. *وكذلك الزهد: يحتاج إلى صبرٍ عن الهوى.* *والعفاف: لا يكون إلا بكَفِّ كَفِّ الشَّرَه،* ولولا ما عانى يوسف عليه السلام، ما قيل له: *﴿أَيُّهَا الصِّدِّيقُ﴾* [يوسف: ٤٦]. صيد الخاطر (ص ٥٨٧ - ٥٨٨).
*أهمية العُزلة والانفراد:* قال ابن الجوزي رحمه الله: *ما أعرف نفعًا كالعُزلة عن الخلق، خصوصًا للعالِم والزاهد؛* فإنك لا تكاد ترى إلا شامتًا بنكبةٍ، أو حسودًا على نعمةٍ، أو مَن يأخذ عليك غلطاتِك! *فيا للعزلة! ما ألذَّها! سلمَتْ من كَدَر غيبةٍ، وآفاتِ تَصَنُّعٍ... وتضييع الوقت،* *ثم خلا فيها القلب بالفكر بعد ما كان مشغولًا عنه بالمخالطة، فدبَّر أمر دنياه وآخرته،* فمَثَلُه كمَثَل الحِمْيَة، يخلو فيها المَعِيُ بالأخلاط فيُذيبُها. *وما رأيتُ مثلَ ما يصنع المُخالِط؛ لأنه يرى حالتَه الحاضرة مِن لقاء الناس وكلامهم، فيشتغل بها عمَّا بين يديه،* فمَثَلُه كمَثَل رجلٍ يريد سفرًا قد أَزِفَ، فجالَسَ أقوامًا، فشغلوه بالحديث حتى ضُرِبَ البُوق وما تزوَّد! *فلو لم يكن في العُزلة إلا التفكير في زاد الرحيل، والسلامة من شر المخالطة، لكفى.* ❍ *ثم لا عُزلة على الحقيقة إلا للعالِم والزاهد؛ فإنهما يعلمان مقصود العُزلة، وإن كانا لا في عُزلةٍ:* ➢ *أما العالِم: فعِلمُه مُؤنِسُه، وكتبُه مُحدِّثُه، والنظر في سِيَر السلف مُقوِّمُه، والتفكير في حوادث الزمان السابق فُرجَتُه،* فإن ترقَّى بعلمِه إلى مقام المعرفة الكاملة للخالق سبحانه، وتشبَّث بأذيال محبته: تضاعفت لذَّاتُه، واشتغل بها عن الأكوان وما فيها، فخلا بحبيبِه، وعَمِلَ معه بمقتضى علمِه. ➢ *وكذلك الزاهد: تعبُّدُه أنيسُه، ومعبودُه جليسُه*... *إنما اعتزلا ما يُؤذي، فهما في الوحدة بين جماعةٍ، فهذان رجلان قد سلما من شر الخلق، وسلم الخلق من شرورهما،* بل هما قدوةٌ للمتعبدين، وعَلَمٌ للسالكين: يَنتفِع بكلامِهما السامعُ، وتُجري موعظتُهما المَدامعَ، وتنتشر هيبتُهما في المَجامعِ، فمَن أراد أن يتشبَّه بأحدِهما، فليصابر الخلوةَ وإن كَرِهَها، ليُثمِرَ له الصبرُ العسلَ. ¤ *وأعوذ بالله من عالِمٍ مُخالِطٍ للعالَم، خصوصًا لأرباب المال والسلاطين، يَجتلِب ويُجتلَب، ويَختلِب ويُختلَب، فما يحصل له شيءٌ من الدنيا إلا وقد ذهب من دينِه أمثالُه! ثم أين الأَنَفَة من الذُّلِّ للفُسَّاق؟!* *فالذي لا يبالي بذلك هو الذي لا يذوق طعم العلم، ولا يدري ما المراد به*... ¤ *وكذلك المُتزهِّد إذا خالَطَ وخلَّطَ؛ فإنه يَخرج إلى الرياء والتصنُّع والنفاق، فيفوتُه الحَظَّان، لا الدنيا ونعيمُها تَحصُلُ له، ولا الآخرة.* *فنسأل الله عزَّ وجلَّ خَلوةً حُلوةً، وعُزلةً عن الشر لذيذةً، يَستصلِحُنا فيها لمُناجاتِه، ويُلهِمُ كلَّا منا طلبَ نجاتِه. إنه قريبٌ مُجيبٌ.* صيد الخاطر (ص ٥٨١ - ٥٨٢).
*أهمية كتمان الأسرار:* قال ابن الجوزي رحمه الله: *رأيت أكثر الناس لا يتمالكون من إفشاء سرِّهم، فإذا ظهر، عاتبوا مَن أخبروا به.* فوا عجبًا! كيف ضاقوا بحبسه ذرعًا، ثم لاموا مَن أفشاه؟! وفي الحديث: *«استعينوا على قضاء أموركم بالكتمان».* *ولَعمري، إن النفس يصعب عليها كتم الشيء، وترى بإفشائه راحةً،* خصوصًا إذا كان مرضًا أو همًّا أو عشقًا، وهذه الأشياء في إفشائها قريبةٌ. *إنما اللازم كتمانُه احتيالُ المحتال فيما يريد أن يُحصِّل به غَرَضًا؛ فإن من سوء التدبير إفشاء ذلك قبل تمامِه، فإنه إذا ظهر، بطل ما يراد أن يفعل، ولا عذر لمن أفشى هذا النوع، وقد كان النبي ﷺ إذا أراد سفرًا ورَّى بغيره.* فإن قال قائل: إنما أُحدِّث مَن أَثِقُ به. قيل له: *وكل حديثٍ جاوز الاثنين شائعٌ، وربما لم يكتم صديقُك،* وكم قد سمعنا مَن يحدِّث عن الملوك بالقبض على صاحبٍ، فنُمًَ الحديث إلى الصاحب وهرب، ففات السلطان مراده! *وإنما الرجل الحازم الذي لا يتعداه سرُّه، ولا يفشيه إلى أحدٍ.* *ومن العجز: إفشاء السر إلى الولد والزوجة، والمال من جملة السر،* فاطِّلاعُهم عليه: - إن كان كثيرًا، فربما تمنَّوا هلاك المُورِّث، - وإن كان قليلًا، تبرَّموا بوجوده، وربما طلبوا من الكثير على مقدار كثرته، فأتلفتْه النفقات. *وستر المصائب من جملة كتمان السر؛ لأن إظهارَها يَسُرُّ الشامت، ويؤلم المُحِب.* *وكذلك ينبغي أن يكتم مقدار السن؛* - لأنه إن كان كبيرًا استهرموه، - وإن كان صغيرًا، احتقروه. ومما قد انهال فيه كثيرٌ من المُفرِّطين: أنهم يذكرون بين أصدقائهم أميرًا أو سلطانًا، فيقولون فيه، فيبلغ ذلك إليه، فيكون سبب الهلاك. *وربما رأى الرجل من صديقه إخلاصًا وافيًا، فأشاع سرَّه، وقد قيل:* *احذر عدوَّك مـرةً ..... واحذر صديقَك ألـفَ مـرة* *فَلَرُبما انقلبَ الصديـ ..... ـقُ فكان أدرى بالمَضَرَّة* ورُبَّ مُفْشٍ سرَّه إلى زوجةٍ أو صديقٍ، فيصير بذلك رهينًا عنده، ولا يتجاسر أن يطلِّق الزوجة، ولا أن يهجر الصديق، مخافة أن يَظهر سره القبيح. *فالحازم مَن عامل الناس بالظاهر، فلا يضيق صدره بِسرِّه.* *فإن فارقتْه امرأةٌ أو صديقٌ أو خادمٌ، لم يقدر أحدٌ منهم أن يقول فيه ما يكره.* *ومِن أعظم الأسرار: الخلوات، ليحذر الحازم فيها من الانبساط بمرأى من مخلوقٍ.* صيد الخاطر (ص ٥٧٨ - ٥٨٠).
*حكم بناء الدُّور المزخرفة، ودعوة الفقراء إليها:* قال ابن الجوزي رحمه الله: *دعانا بعضُ الناس، وقد زخرَفَ دارَه وزَيَّنَها وحلَّاها بالذهب، وجمع فيها جماعةً من الفقراء، وقدَّم إليهم الأطعمة السَّنِيَّة.* فقلتُ: هذا فعلٌ يُقارِبُ الحرامَ؛ لأن الله تعالى إنما *نهى عن الحرير لئلا ينكسر قلب الفقير، وأمر بالتعري في الإحرام ليتوافق الغني والفقير.* *ومَن أحضَرَ الفقراءَ فأراهم هذا البنيان العجيب المزخرف فقد أشهَدَهم على تضييع المال وإنفاقِه فيما لا يجوز، وحرَّك قلوبَهم إلى التسخط على المقدور؛* لأن في كل نفسٍ شهوةً لمثل ذلك، فإذا رجع الفقير إلى داره نَقمَها وازدَرَاها وتكدَّرَ عيشُه، خصوصًا إن كانت له هِمَّةٌ، فإن تحرَّك في تحصيل مثل هذه الأشياء لم تَكَدْ تَحصُل إلا بوجوهٍ مرذولةٍ وفعلٍ لا يجوز... *ثم كيف يأمن إصابة العين؟! وتعريضُ النِّعَم للعيون مُخاطَرَةٌ لا تَفي بإظهار النِّعَم.* *فهذا البنيان منهيٌّ عنه،* *والإنفاق فيه على هذا الوصف لا يجوز،* *وإطلاعُ الناس عليه:* - *إطلاعُ الشهود على فجور،* - *وتعريضٌ لهم بالتسخط على الأقدار،* - *وتعريضٌ لنفسه بإصابة العين.* وكل هذا لا يَصلُح ولا يَليق. *وقد كان ينبغي أن يجعلَ شكرَ النعمة التي يَعتقِدُها نعمةً: صلة الفقراء وهم في بيوتهم؛ لئلا يَرَوْا مثلَ ذلك.* صيد الخاطر (ص ٥٤٥).
*هل يعلم الموتى بطُول مكثِهم في القبور؟* قال ابن الجوزي رحمه الله: سأل سائلٌ: *هل يعلم الموتى بطول مكثِهم في القبور؟* فأجبت: *الله أعلم بحقيقة ذلك، غير أن الذي يظهر لنا بمقدار علومنا أن الأبدان قد بَلِيَتْ، فالحواسُّ المُدرِكة معدومةٌ، وآلات العلم مفقودةٌ، وليس ثَمَّ إلا الأرواح،* وقد جاء في الحديث الصحيح: *«أنها في حواصل طيرٍ خُضْرٍ تأكل من شجر الجنة»،* وهذا يقتضي أنها مُودَعةٌ في محلٍّ يُتصرَّف بها ولا تَتصرَّف فيه، *فكأنها من جنس ما يجري في المنام لها؛ فإنها مُودَعة في البدن، وآلات تصرُّفِها مُعطَّلةٌ، فهي ترى في مَنامِها ما تَلَذُّ به وما يؤذيها، ولا تدري قدرَ مدة النوم،* فإدراكُها قاصرٌ بعد الموت، فعلى هذا ليس لها علمٌ بمقدار مدة اللبث من حين الموت إلى البعث. ومن هذا الجنس: قول أهل الكهف: *﴿لَبِثْنا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾* [الكهف: ١٩]، وذلك أنهم ناموا أولَ النهار وانتبهوا في آخرِه، ولم يعلموا قدرَ مكثِهم في النوم. ومن هذا النوع: البعث، ويدل على هذا قوله تعالى: *﴿وَيَومَ يَحشُرُهُم كَأَن لَم يَلبَثوا إِلّا ساعَةً مِنَ النَّهارِ﴾* [يونس: ٤٥]، ولهذا يُقال: *﴿كَم لَبِثتُم فِي الأَرضِ عَدَدَ سِنينَ. قالوا لَبِثنا يَومًا أَو بَعضَ يَومٍ فَاسأَلِ العادّينَ﴾* [المؤمنون: ١١٢-١١٣]. فإن قيل: فأين تأثيرُ العذاب في قوله ﷻ: *﴿النّارُ يُعرَضونَ عَلَيها غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾* [غافر: ٤٦]؟ وأين تأثير النعيم في قوله ﷺ: *«ما منكم أحدٌ إلا ويُعرَض عليه مقعدُه من الجنة أو النار غُدوةً وعشيَّةً، فيُقال: هذا مَقعَدُك حتى يبعثَك الله إليه»؟* فالجواب: إن النعيم والعذاب في الحديث مع الأرواح، فهي التي تُنعَّم وتُعذَّب، إلا أنها قد عُدِمَتْ آلاتُها التي تُدرِك بها عِلمَ مقادير الزمان، *فإذا عادت إلى الأبدان وتصرَّفت في آلات الإدراك، نَسِيَتْ ما كانت فيه.* ويمكن أن يُقال: إن *الناس إذا بُعِثوا هالَهم ما يَرَوْنَ من أهوال القيامة، فيَنسَوْنَ طولَ ما قدموا عليه.* والله أعلم بحقيقة ذلك. صيد الخاطر (ص ٥٥٣ - ٥٥٤).